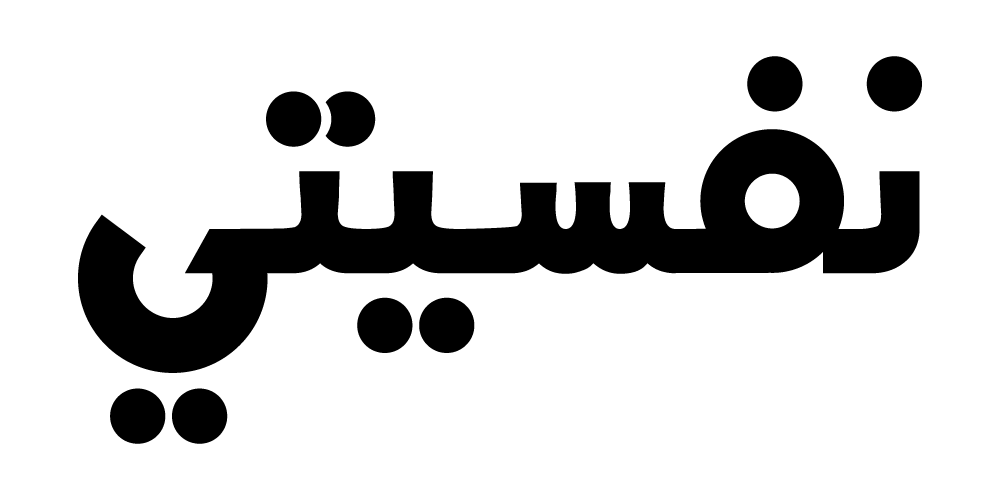لا تُنسى خدوش الحاضر الصّغيرة كما لا تندمل جراح الماضي الغائرة. هذا ما يحدثُ حين يستمرّ البعضُ في حمل الضّغينة في قلبه اتجاه من ألحقوا به الأذى. وهنا يحضرُ السّؤال: كيف تتجذر الضغينة في النّفوس؟ وكيف نتخلّص منها؟
الأسباب
تحكي سيلفيا البالغة من العمر 35 سنة: "البعضُ يُفضِّل تقديم طبق الانتقام بارداً، أما طبقي أنا، فأتركُه إلى أن يتجمَّد!". من منّا حقاً لم يسبق له أن سعى بعد مشاحنةٍ أو أذى أو إهانةٍ لحقا به إلى الانتقام؟ أو على الأقلّ انتابته الرّغبة في ذلك؟
ما يميّز الضّغينة عن غيرها بشكلٍ عام، أننا نقدم على فعل كل ما في وسعنا كي لا تنتقل هذه الرغبة في الانتقام إلى حيّز التنفيذ. ترى المعالجة النّفسية الكندية ميشيل لاريفي: "أنَّ مردّ هذا الشعور غضبٌ عميق وراسخٌ. صحيحٌ أنّ مُجرّد استحضار الظروف التي سبّبته قد يدفعُ به أحياناً ليطفو من جديد على السّطح؛ لكنّه يتجذَّرُ في نفوسنا لا ليغادرها بل ليُقيم فيها ولأجلٍ غير مسمّىً أحياناً".
تقدّم لوسي البالغة من العُمر 45 سنة مثالاً واضحاً على ذلك؛ إذ لا تزالُ تحملُ في قلبها ضغينةً اتجاه أخيها الذي ظلّ طوال طفولتها يحطّ من قدرها. "لم أقابله منذ خمسٍ وعشرين سنة لأني لم أستطع مسامحته قطّ على ما جرَّعهُ لي من ألم". ثمة أشخاص كثر مثل لوسي، يصلُ بهم الأمر إلى قطع جسور التواصل تماماً بمن أخطأ في حقّهم، فيما يكتفي آخرون بإضمار الشّعور بالسّخط.
طريقُ العلاقات المسدود
يُمثّل الاحتفاظ بالضّغينة دخولاً في علاقة قوّة مع كلّ ما من شأنه أن يُخلَّ بموقفك الثّابت في رفضِ ما حصل لك. تميّز ميشيل لارفي بين الضّغينة باعتبارها ذلك الشّعور الدّائم بالعداء، وبين الحُنق أو الحقد اللذَيْن يُضاف إليهما شعور بالحزنِ يتوارى خلف ستار الغضب. وإذا كان التّحامُل هو أساس الضّغينة، فإنّ مَردّ الشعور بالحقد هُو السُّخط على واقع مُعاش؛ كوقوعِ ظُلمٍ واضح أوْ خيبة أملٍ عميقة. صحيحٌ أن الاختلافات بينهما لا تقف عندَ هذا الحدّ، فالضّغينة تظلّ على مستوىً واحد في النّفس، فيما الحقد يأخذ شكل شعور راسخ بالوسع استدعاؤه وإعادة إحيائه في أيّ لحظةٍ نريد؛ إلا أن ما يجمع بينهما هو أنّ دخول أيّ منهما إلى أيّ علاقة يعني وصولها إلى طريقٍ مسدودة.
"أتعامل مع رئيسي في العمل بطريقةٍ مُتحفظة وباردة منذ رَفضَ منحي العلاوَة التي أستحقّ" يصف سيباسيتان ما يحسّ به ويستطرد: "لكني لن أفاتحه أبداً في الموضوع، لا أرى لذلك أي جدوى". هذه الاستراتيجيّة كما هو واضح، لن تُعجِّلَ بالعلاوة المتأخرة؛ كما لن تكفل تواصلاً صحياً.
عاطِفة مؤذية
تتجذّر آليات عمل كلّ من الضغينة والحقد في أرض الطّفولة الأولى حين يقفُ الأهل في وجهِ تعبير الطّفل عن استيائه، ولهذا نلجأ إليهما للحفاظ على جذوة الغضب مشتعلة ورابطتنا العاطفية ممتدةً مع تجربةٍ قديمة. لكن وفقاً لميشيل لارفي: "من شأنِ إخلاصنا لهذه التجربة السّيئة تجميدنا في وضعية انغلاق على الذات والحيلولة دون دخولنا علاقات جديدة من شأنها إصلاح ما تمّ إفساده".
تثقلُ الضغينة كاهل المرء بمشاعر من الأسى والضِّيق؛ إذ تؤكّد كلّ الدراسات التي تناولت المشاعر السّلبية أنّ الحنق أو الحقد مشاعر من شأنها أن تجعل من المرء فريسة سهلةً للاكتئاب واضطربات القلق والضغط وآلام الرأس واضطرابات النّوم. من جهةٍ أخرى تفيدُ هذه الدراسات كذلك، أنّ النجاح في التخلص من غضبنا الدّاخلي من شأنه أن يُحسّن من مستويات الطّاقة وجودة النّوم وضربات القلب؛ إلا أن هذا الخلاص لا يتحقّق إلا بالمرور بمحطّة مهمة وهي: الغفران.
الحلول
عبّروا عن أنفسكم
تتمثّل الطريقة الأنجع للتخلص من الشعور بالحقد، في الإفصاح عنه للشّخص الذي تسبَّب فيه. إذا كُنتم تستصعبون التواصل الشّفهي، بإمكانكم أن تكتبوا لهم وتُسهبوا في تعداد أسباب غضبكم ووصف شعوركم المُمِضَّ بالظُلم وكذا الأذى الذي ألحقوه بكم. بوسعكم أيضاً أن تتحدثوا عن رغبتكم في الانتقام وردّ الاعتبار! من حقكم أن تُصرحوا لهم كتابةً أو قولاً أنّه: "لأجل كلّ ما سبق لا أرغبُ في رؤيتكم مجدداً" فالهدف وراء اتباع هذه الخطوات ليس عقد صلحٍ بينكم وبينهم وإنّما إيجاد السلام مع أنفسكم أنتُم أولاً وقبل كُلّ شيء.
اصفحوا
ما أسهلَ القول، وما أصعبَ الفعل! هذا صحيح لكن مع ذلك لا بديل عن المسامحة للتخفيف من الضغينة. يتطلّب منكم هذا القرار وضعُ حنقكم ورغبتكم في الانتقام جانباً والتفكير ملياً في الأسباب التي تقفُ خلف غضبكم وما يترتّبُ عن شعوركم هذا من ألم. إذا كنتُم تخططون لإعادة إحياء التواصل من جديد مع الشّخص الذي تسبّب في أذيّتكم؛ أعرِبوا له بطريقة لفظية أو جسدية عن مسامحتكم له كأن يأخذ هذا التعبير شكل عناقٍ مثلاً.
نصائح تتعلق بمحيطكم
إذا شعرتم أنّ شخصاً ما يحملُ في قلبه ضغينةً اتجاهكم، فاسمحوا له بالتعبير عن كلّ الأشياء التي يجدُها مؤذية في تصرفكم. يتحتّم عليكم أيضاً أن تكونوا قادرين على قول وجهة نظركم بصدق وبلا تزييف فيما أقدَمتم على فعله. إذا كان شريككم في الحياة من النّوع الذي يراكم الضغائن في قلبه، فجربوا معه لعبة "كيس الرّمل": اعقدوا معاً جلسةً كلّ شهر خاصّة بالفضفضة، أفرغا خلالها دفعةً واحدة ولمدّة دقيقتين وخمس عشرة ثانية كلّ ما لديكما بما في ذلك الأشياء التي يصعبُ قولها أو سماعها. امنحا نفسيكما بعدها فسحةً للغضب تنتهي بمرور ثلاث دقائق وعشرين ثانية، وهكذا نُفرغ الكيسَ، ويتسرّب الرمل.
شهادة
تلخّص صوفي البالغة من العمر 41 سنة والتي تعملُ سكرتيرة في إدارةٍ، تجربتهَا بقولها: "مَنحتني كتابةِ رسالةٍ من عشرين صفحة حُريّتي".
وتوضح: "اعتادَ والديّ الانتقاص من ذكائي بالقول أنه لن يسعفني لإتمام دراستي وكذا السّخرية من صديقاتي وأيّ شابّ جرَّبتُ الارتباطَ به. ولهذا ظللتُ ولمدّة سنواتٍ طويلة ألقي باللائمة عليهما أن أوصلاني إلى أن أزهد في الدّخول في أيّ علاقةٍ مع الآخرين وينتهي بي المطافُ إلى إقناع نفسي أنّ العلاقات الجيدة هي تلك العلاقاتُ التي لا وجود لها وأشتغل سكرتيرة دون أن ينبع اختياري هذا عن اقتناع. في أحد الأيام صارحتني زميلةٌ لي في العمل بقولها أنها لم تقابل من قبلُ في حياتها شخصاً حذِراً وحانقاً مثلي؛ يجدُ في كل شيء حولهٍ سواء كان حديثاً ساخراً أو نظرةً أو مُجرّد سَهْوٍ مبرراً للحقد.
ثمّ اقترحَت عليّ: "لمَ لا تُفرغينَ كلّ ما تشعرين به في رسالةٍ توجّهينها إلى والديك عوضَ أن تُحمِّلي العالم كُلّه المسؤولية؟" وهكذا مَنحتني كتابةِ رسالةٍ من عشرين صفحة حُريّتي!
طلبَت مني هذه الزميلة أن أسمح لصديقها بقراءة تلك الرّسالة. رحَّبْتُ بالأمر، وكان ذلك بداية نقاشٍ طويل معه اكتشفتُ خلاله أنه مَرَّ بتجربةٍ مشابهة. عرَّفني صديقُ زميلتي هذا فيما بعد إلى أحدِ معارفه والذي صار الآن شريكي في الحياة. أمّا الرسالة، فقد أدَّتْ غرَضها دون حاجةٍ مني إلى إرسالها. وعوضَ أن تُقرأ من طرف شخصين اثنين هُما والديّ؛ اطَّلع عليها أشخاص آخرون وعلَّقُوا عليها وفي كلّ حديث نخوضهُ حولها خطوة تقرّبني من نفسي".