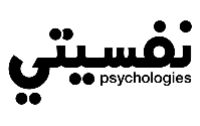“هل حدث هذا المشهد فعلاً؟”، “هل حدث فعلاً كما أتذكر؟”. جميعنا نرغب بأن نعرف ما إذا كانت ذكريات طفولتنا موثوقة، فهي تشهد على سنوات حياتنا الأولى وتساعدنا على أن نفهم كيف أصبحنا الشخص البالغ الذي نحن عليه الآن. ولو كانت الذكريات زائفةً كلياً، ماذا لو أنها رغم ذلك تنقل لنا أفكاراً صحيحةً؟
“كنت جالساً في عربة أطفال كبيرة تدفعها مربيتي في شارع “الشانزيليزيه” قرب “القصر الكبير” (Grand Palais)، وفجأةً اقترب أحد الأشخاص وأراد اختطافي؛ لكن الحزام الجلدي الذي يربطني بالعربة شدني للخلف وحال دون ذلك، في حين حاولت مربيتي منع الرجل بشجاعة (حتى أنه أصابها ببعض الخدوش وما زالت الصورة المبهمة لجبهتها المخدوشة محفورةً في عقلي)، ثم تجمع حشد من الناس واقترب شرطي […]؛ ما دفع الرجل إلى الهرب. ما زلت أرى المشهد بأكمله وحتى أنني أميز موقعه قرب محطة قطار الأنفاق”.
على الرغم من الواقعية والدقة الشديدة لهذه الذكرى الشخصية التي رواها العالم النفسي السويسري الشهير المتخصص في تنمية الطفل “جان بياجيه”؛ فإنها زائفة بالكامل من كتابه “تعليم الأطفال بالرموز” (La Formation du symbole chez l’enfant). ظل يعتقد أنه تعرض لمحاولة اختطاف عندما كان صغيراً حتى سن المراهقة، إلى أن اعترفت مربيته السابقة في رسالة بأنها اختلقت القصة لتلفت الانتباه إلى نفسها؛ لكن بسبب سماعه القصة من والديه اختلق “جان” ذكرى عنها. ويوضح أن “الإنسان يحتفظ بالعديد من الذكريات التي يظنها حقيقية حتماً لنفس السبب”؛ إذ تصاغ الذكرى وتظل راسخةً في ذهنه لأن عائلته تذكرها كثيراً. صرنا نعلم أن دماغ طفل يبلغ من العمر عامين لم يتطور بما يكفي ليتصور مثل هذه الذكريات المعقدة.
لكن حتى اليوم، تماماً كما هو الحال في الوقت الذي كتب فيه “جان” تلك السطور في عام 1945، لا توجد طريقة تتيح لنا أن نجزم أي ذكرياتنا حقيقية وأيها زائفة، فكلاهما تبعثان في أنفسنا مشاعر شديدة وتحملان كماً هائلاً من التفاصيل. نبدأ بتخزين المعلومات منذ وجودنا في الرحم لكن لا يمكننا تسميتها ذكريات بمدلولها الصحيح قبل اكتساب مهارة اللغة. ومع ذلك يزعم البعض أنهم يحتفظون ببعض ذكرياتهم منذ الأشهر الستة الأولى من حياتهم وحتى منذ ولادتهم. هل هي ذكريات زائفة؟ ليس بالضرورة. “يمكن أن نتذكر انطباعنا الأول عن موقف يتجلى فيه الخير والحب؛ مثلاً ابتسامة أمنا”، هذا ما يؤكده المحلل النفسي “أوليفييه دوفيل” الذي ألّف كتاب “الجسد بين الحقيقة والمظهر” (Du corps, le réel et le semblant) بالمشاركة مع “غورانا بولات مانينتي” و”سيلفيا ليبي”.
عامل القدرة على التكيف
لكن من ناحية أخرى فالكثير من أوائل ذكرياتنا لم نحفظها وإنما تخيلناها واختلقناها. تقول جوليا ذات الـ 32 عاماً التي تعمل ساعية بريد: “كثيراً ما روى لي والداي قصة نسياني عندما كنت طفلةً في المتجر. وأنا أتذكر حدوث ذلك نوعاً ما؛ لكنني أذكر أنني بقيت وحيدةً لفترة طويلة جداً في حين تدعي والدتي أنها عادت فوراً لاصطحابي”. وكان هذا المشهد يطارد جوليا لدرجة أنه يوجّه كل خطوة لها، فحتى تتجنب “أن تُنسى وتُترك” مجدداً سعت في جميع الظروف أن تبدو عنصراً أساسياً بين أفراد عائلتها وفي محيطها المهني.
هل ينبغي لنا أن نسعى للتحقق من حقيقة ذكرياتنا؟ فجميع ذكرياتنا مشكوك بحقيقة حدوثها. يتابع “أوليفييه دوفيل”: “لا وجود لذكريات نقية لم يتخللها خيالنا وثابتة لا تتغير بشكل نهائي”. إنها تتغير وتتعدل مع مرور السنين، فنحن نتذكر الأحداث ليس كما حدثت فعلاً بل كما نعيشها. لهذا لا تتطابق ذكرياتنا مع ذكريات إخواننا وأخواتنا.
ولكن من ناحية أخرى، فذكرياتنا حتى لو لم تكن دقيقةً أو حقيقيةً بالكامل إلا أنها تحمل الحقيقة دائماً بين طياتها. ووضح ذلك المحللة والمعالجة النفسية “فيرجيني ميغَليه” بقولها: “لا تحمل الحقيقة بمعناها الحرفي وإنما الحقيقة من وجهة نظرنا”. هذا هو الفرق الأساسي بين الواقع الملموس والمشهد الذي نتذكره عنه، الأشبه بمسرح الظل الذي يسميه “فرويد” بـ “الواقع النفسي”. وإضافةً إلى ذلك؛ يشرح الطبيب النفسي العصبي والعالم في سلوك الحيوان “بوريس سيرولنيك” أننا عندما نعيش تجربة قاسية يجمّل عقلنا ذكراها لدينا كوسيلة للتكيف والتعافي؛ بل لمساعدتنا على الاستمرار في الحياة: “من لا يفكر من هذا المنظور يبقى أسير ماضيه وقلقه وألمه، فالذكريات الزائفة تتيح لنا أن نعيد صياغة المشاهد في داخلنا وأن نعثر على بصيص أمل. مثلا:ً ليس كل الرجال أوغاداً، ولكل مشكلة حل”.
يلاحظ الجميع ذلك، فعقولنا تجعل ذكرياتنا الصارخة متضاربةً وغامضةً. تلاحظ “فيرجيني ميغَليه”: “لا يترك الفرح أثراً، في حين أن المشاهد المزعجة التي تهزنا هي التي تترسخ في عقولنا”. ومع أن الطفولة تمتد لسنوات إلا أننا في النهاية لا نحتفظ إلا بقدر محدود جداً من الذكريات؛ ربما ثلاث أو أربع أو خمس أو أكثر قليلاً فقط. يقول “أوليفييه دوفيل”: “نحن ننتقي الذكريات التي نحتاجها لبناء أنفسنا أو الذكريات التي تبرر الصعوبات التي نواجهها عندما نكبر. مثلاً لماذا لا أحب، لماذا لا أثق بنفسي، لمَ لا أنجح على الصعيد العاطفي؟ وغير ذلك.
أهمية الذكريات الزائفة
تقول الموظفة اللوجستية ديما ذات الـ 51 عاماً أن مواضع الخلل في ثقتها بنفسها تعود إلى الموقف الذي عرضت فيه مغنية مشهورة كانت صديقة لوالديها أن تقدم لها قبعةً لتخفي وجهها لأنها كانت قبيحةً جداً. “ومنذ ذلك اليوم وأنا أخفي نفسي”. تعلق “فيرجيني ميغَليه” على هذا بقولها: “لا يرجَّح وجود علاقة سببية كهذه. أعتقد أن هذه الذكرى تبلور شعورها بالضيق الذي يوجد لديها أصلاً.
لطالما تذكرت منى ذات الـ 22 عاماً التي تعمل سكرتيرة أمها الغائبة المستغرقة في عملها إلى أن أدركت أن غياب والدتها وسفرها خارج المدينة لتلبي التزاماتها المهنية كان في ثلاث مناسبات فقط، ولم تفوّت غيرها أبداً: “كانت والدتي حاضرةً أكثر بكثير من والدي، فقد كانت تعود إلى المنزل الساعة الخامسة مساءً، أما والدي لا يعود إلا في الساعة 8 مساءً. ورغم ذلك فإن هذه الذكريات الزائفة تعبر عن الحقيقة التالية: تشعر منى أن والدتها كانت دائماً بعيدة عنها نوعاً ما، ولم تكن تعتني بها كما يجب. ومع ذلك عندما نواجه بعض الذكريات المزعجة التي تتعلق بوالدينا فإن الحقيقة – الحقيقة التي وقعت في الماضي – هي التي نريد تذكرها.
لا تزال البائعة لورا ذات الـ 38 عاماً تتساءل عما إذا كانت تحلم بهذا المشهد أم أنه حدث فعلاً: “كنت في الرابعة أو الخامسة من عمري، ورأيت والدتي تخبر صديقتها أنها ستتجاوز ألم وفاة أطفالها أسرع من ألم وفاة زوجها. أخبرتني بعد ذلك بفترة طويلة أنها يستحيل أن تنطق بمثل هذا الكلام”. يقول “أوليفييه دوفيل”: لسوء الحظ “ليس الآباء أفضل شهود على الحقيقة؛ إذ يمكنهم إنكار حدوث مواقف حقيقة حدثت فعلاً لأنها تعكس عنهم صورةً لا يتحملونها. لقد شهدت بعض الناس يتذكرون فجأةً كلمات أو تصرفات صدرت عنهم فيسوؤهم تذكرها”. ولأن الأسرة هي موطن العواطف والمسائل الغريزية التي تكون غالباً عنيفةً ولاواعية، فتكون الذكريات المؤلمة فيها من نصيبنا. تجيب “فيرجيني ميغَليه”: تستحيل حماية الصغار حمايةً كاملةً لأننا “لا نستطيع أن نعرف كيف سيعيش الطفل حدثاً من وجهة نظره وكيف سيتذكره”. فقد تعجب كلمة أو موقف أحداً وتسوء أحداً آخر. قبل كل شيء؛ نحتاج إلى الخيال والقصص التي نرويها سواءً الحقيقية منها أو الزائفة لنشعر بذواتنا. كثيرا ما أقول لمرضاي: ذكريات طفولتنا هي أصدقاؤنا، حتى أكثرها ألماً”.
ثلاثة أسئلة نطرحها على “بيير بلونك سانون”
“تتغير ذكرياتنا خلال حياتنا”
يعلمنا “بيير بلونك سانون” النهج السردي في مدرسة “لا فابريك ناراتيف” أو صناعة الرواية (La Fabrique narrative) التي شيدها في مدينة “بوردو”.
سؤال مجلة “بسيكولوجي” (Psychologies): ما هو النهج السردي؟
“بيير بلونك سانون”: تقوم هذه الممارسة على مبدأ أن الحياة مبنية على القصص التي نختار أن نرويها لأنفسنا. يساعدنا بعضها على مواصلة العيش من خلال إظهار أحلامنا وآمالنا لنا، وبعضها الآخر يعيقنا ويغلبنا. تتمثل وظيفة الممارِس في لفت نظر الشخص إلى الأحداث التي تغاضى عنها رغم أنها تستحق أن يسلط الضوء عليها.
ما موضع ذكريات الطفولة من هذه القصص؟
“بيير بلونك سانون”: عادةً تعاد صياغتها وتعدّل. ولأنها قصص أعيدت صياغتها، فإنها تتغير طوال حياتنا حسب نظرتنا لأنفسنا عندما نرويها.
هل الوعي كافٍ؟
“بيير بلونك سانون”: الوعي هو المرحلة الأولى: المشكلة “خارجية” ومنفصلة عن نظرة الإنسان لنفسه. والمرحلة التالية تكون بتحديد الاستراتيجيات التي سيطبقها لمحاولة التغلب على هذه المشكلة. كما نلاحظ الأحداث التي لم تكن فيها المشكلة موجودة. هذه فرصة للشخص ليروي لنفسه قصةً مختلفةً، وبالتالي ليغير نظرته إلى نفسه ويدرك إمكانياته.