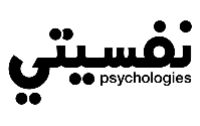ملخص: السعادة مطلب عزيز يركض الإنسان وراءه منذ بدء الخليقة. يبحث عنه في مناحي الحياة كلّها ويبذل الغالي والنفيس من أجل بلوغه. ومع ذلك، تلبّد غيوم التعاسة سماء هذه الرحلة التي لا تكاد تنتهي حتّى تبدأ من جديد، فهل من المجدي أن يسعى الإنسان وراء السعادة أم من الأفضل له أن يستسلم لظروف الحياة؟ وهل من الممكن أن ينعم المرء بالسلام الداخلي على الرغم من تعاسته؟ وما السبيل إلى استيعاب المعنى الحقيقي للسعادة؟ يجيب المقال التالي عن هذه الأسئلة الفلسفية والوجودية، ويقدّم رؤية واقعية لمعنى السعادة.
هل من الممكن أن تعيش في سلام وأنت تعيس؟ قد يبدو هذا الطلب بعيد المنال. يبرز هذا السؤال في عالم يؤدي فيه السباق المحموم نحو السعادة إلى ضغط مضرّ بالجميع؛ حيث يتعرّض هذا المفهوم إلى التشييء باعتباره مجرد سلعة مثل باقي السلع التي يجب الحصول عليها. ومع ذلك، لا أحد يستطيع أن ينكر تطلّعه إلى السعادة. إنّها تبدو في متناولنا جميعاً، ومن واجبنا أن نسعى إليها وأن نجعلها هدفنا الحتمي في الوجود؛ لكن قد يكون هذا السعي مصدر معاناة إضافي.
لقد اجتاح الهوس ببلوغ السعادة عالم العمل على سبيل المثال بعد أن أضحى متداولاً بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي بفضل ممارسات التنمية الذاتية، فظهرت مفاهيم جديدة في المجال المهني تعكس هذه الظاهرة مثل منصب “كبير مسؤولي السعادة”. وأطلقت الشركات مبادرات لتحسين رفاهية الموظفين (جلسات التدليك ودروس اليوغا وإدارة التوتر وغير ذلك). كما شرعت في إجراء استقصاءات لقياس مستويات رضا الموظفين وإدماج مفهوم “السعادة” في قيمها وثقافتها، قبل أن يتأثر هذا المجهود كلّه بأزمة جائحة كوفيد-19 التي وضعتنا جميعاً أمام تحديات جديدة وغيّرت طبيعة علاقتنا بالعمل. كانت السعادة موضوع دراسة فلسفية منذ آلاف السنين، كما اهتمت بها اتجاهات مختلفة في علم النفس، وأصبحت مسألة سياسية واقتصادية نسعى باستمرار إلى قياسها وتقييمها، ومع ذلك فقد ظلّت مفهوماً صعب التحديد والضبط.
هناك على سبيل المثال مؤشّر العيش الأفضل الذي يقيس مستوى الرفاهية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتقرير العالمي حول السعادة الذي تنشره الأمم المتحدة. السعادة مفهوم معقّد وذاتي ويرتبط أساساً بجانب خيالي لأنّ لكلّ منّا تصوّره الشخصي وتجربته الفريدة. كما أنها قد تصبح أسطورة شخصية أو جماعية باعتبارها أيضاً مطلباً بعيد المنال. ولكلّ فرد منّا أن يحدد طبيعتها: هل هي حقيقية أم وهمية؟
هل ثمة مشكلة إذا لم تكن تشعر بالسعادة؟
كلّما زادت الظروف المقلقة تزايدت الدعوات إلى تحقيق السعادة باعتبارها الدّواء الشافي. ولكن ماذا لو كان هذا السعي وراء السعادة مجرد قناع مؤقت لإخفاء بؤس الحياة؟ ألاحظ أن عدداً كبيراً من الأشخاص الذين أستقبلهم في عيادتي يشعرون بأنهم فشلوا في هذا المسعى. يقول بعضهم: “إذا كنتُ لا أستطيع أن أقول إنني سعيد فهذا يعني أن هناك مشكلة ما”. إنهم يحرصون على فعل ما يلزم للشعور بالسعادة ويتحسّرون على عدم الوصول إليها، فيولّد لديهم ذلك شعوراً بالعار أحياناً وبالذنب في كثير من الأحيان. لذا؛ فإنهم يستشيرونني لطلب أدوات وحلول تساعدهم على “بلوغها”. يطرح هذا الأمر مشكلة الوسائل والموارد المتوفرة للوصول إلى هذه الغاية المنشودة. إننا نعتقد أنّ علينا تطوير هذه الميزة أو تلك المهارة للوصول إليها، وكأنّ السعادة مسألة جدارة واستحقاق. كما أننا نخجل من الشعور بالحزن والإحباط وعدم الرضا والانزعاج بسبب معاناتنا الجسدية أو ظروف الحياة. هذا الهوس لا يساعد على تحقيق السعادة؛ بل يؤدي إلى عكس ذلك. إنه يوهمنا بأننا مسؤولون عن سعادتنا؛ ومن ثمّ فإننا مسؤولون أيضاً عن تعاستنا.
وهذا يعني ببساطة أننا نصبح مذنبين إذا لم نشعر بالسعادة. وهنا يصبح تقديس السعادة سبباً في شعورنا بالوصم؛ وكأن العيش دونها أمر غير مشروع. وإذا اقترن هذا التقديس بضرورة النجاح المطلق والاعتماد على نظرة الآخرين واستحسانهم فإن المقارنة الاجتماعية الناتجة من ذلك قد تؤثر في تقدير الفرد لنفسه وثقته بها. عندما نشعر بأننا لا نستطيع تحقيق هذا الهدف فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالتوتر والقلق والاكتئاب، وهذا من المظاهر السلبية لهذا الاتجاه.
لذا؛ يتحوّل العمل لتحقيق السعادة إلى عبء نفسي ومهمة إضافية يجب إنجازها؛ بينما يصبح إخفاء مظاهر الضعف وكبت المشاعر “السلبية” و”اللامبالاة” واجباً آخر. إنّ الانغماس في هذا المسعى ومحاربة المشاعر الحقيقية قد يعني خسارة ثراء التجربة الإنسانية وتعقيدها. لذلك؛ نحن بحاجة إلى تغيير منظورنا وإعادة التفكير في طبيعة علاقتنا بالسعادة.
كيف تتقبل المعاناة وتعيش بسلام؟
ربما حان الوقت للتوقف عن القلق بشأن هذه المسألة والتريّث قليلاً، لأننا لن نجد السلام الداخلي في السعي المحموم وراء السعادة بأيّ ثمن. يمكن أن نكون تعساء ونشعر بنوع من الطمأنينة والهدوء على الرغم من أن ذلك قد يبدو متناقضاً بل مستحيلاً. وقد يبدو استكشاف هذه الازدواجية في ضوء “نزعة السعادة” السائدة أمراً مقلقاً لأن اعترافنا بحالاتنا العاطفية السارّة وتقبّلها أمر بديهي؛ بينما يظلّ الاعتراف بالحالات العاطفية غير السارّة أقلّ بديهية. فنحن نميل إلى وصف العواطف بأنها “سلبية”، ونسارع إلى وصف حالات التعاسة والضيق الوجودي بأنها مرَضية، علماً أن السعادة لا تعني انعدام المشاعر غير السّارة. في الحقيقة، بإمكاننا أن نشعر بالسلام الداخلي حتّى عندما نمرّ بفترات معاناة جسدية أو نفسية. يمكننا ذلك من خلال تقبّل الواقع والإصغاء إلى الذات والتحلّي بالمرونة والتواصل مع الآخرين ومعرفة القيم الشخصية التي تحرّكنا.
ومع ذلك، إذا كانت المعاناة جزءاً أساسياً من التجربة الإنسانية ومن الطبيعي أن يمرّ الفرد بفترات الحزن أو خيبة الأمل أو الألم، فمن المهم ألّا نغفل الأعراض التي قد تترسّخ بمرور الوقت (فقدان الاهتمام والمتعة وفقدان الوزن أو زيادته، والأرق أو فرط الأرق والهياج أو التباطؤ الحركي، والتعب أو فقدان الطاقة والشعور بانعدام القيمة أو الشعور بالذنب، وصعوبة التركيز والتفكير في الموت أو الانتحار). ويمكن أن تتفاقم هذه المعاناة وتتحوّل إلى شكل من أشكال الضيق العاطفي مثل مرض الاكتئاب الذي يتطلّب متابعة طبية وعلاجاً نفسياً.
إذا لم تكن سعيداً فهذا لا يعني أنك لست بخير. لا تتعارض أشكال المعاناة العادية تعارضاً جوهرياً مع حالة الرضا؛ لأنها متأصلة في التجربة الإنسانية. فالشعور بالهدوء والسكينة لا يلغي حالة المعاناة والقلق أو يقلّلها. وبدلاً من أن ننخدع بالرؤية المتضخّمة لمعنى السعادة، علينا أن نفسح المجال لمشاعر المعاناة وعدم الطمأنينة وعدم اليقين وعبثية الحياة. لكنّ هذا لا يعني الاستسلام لها، بل علينا أن نتعلّم كيف نتعامل معها بطريقة مناسبة، فالسعادة لا تعتمد على الظروف الخارجية بقدر ما تعتمد على حالاتنا الذهنية ومواقفنا وطرائق تعاملنا مع ما يحدث لنا. إنها ترتبط بمدى فضولنا لاستطلاع الأسباب التي تجعل الحياة أكثر راحة، وتجعلنا أكثر قدرة على التحمّل مع تجنّب الانغماس في التفاصيل الفنية الدقيقة لمعنى السعادة.
وقد يقودنا هذا الأمر إلى العثور على مساحة شخصية من السلام الداخلي والراحة النفسية والهدوء، يمكنها أن تدوم في مواجهة تقلّبات الحياة. إننا ببساطة نتصالح مع أنفسنا ونسمح لها بالازدهار من خلال تحريرها من أيديولوجية السعادة هذه، وتحمّل مسؤولية تأمل ذواتنا وامتلاك شجاعة قبول حقيقة الحياة بتقلباتها وأفراحها ومعاناتها.
لقد حان الوقت إذاً لأخذ الأمور ببساطة في سياق هذا الهوس الجماعي الذي أصبحت فيه السعادة ضرورة أخلاقية، والتعاسة أمراً لا يقبله الناس إلا بصعوبة. قد يكون من المقلق أن تتخلى عن سعيك إلى السعادة لأنه ربّما كان هو الخيط الناظم لحياتك، لذا؛ قد تميل إلى ملء هذا الفراغ بشيء آخر. لكن دعونا نتوقّف عن الركض وراء شيء آخر، فهذا لن يؤدي إلا إلى إطالة دورة عدم الرضا وخيبة الأمل الناجمة عن بحث لا ينتهي. إنّ التخلي عن عبء السعي وراء السعادة بأيّ ثمن سيكون مريحاً لأننا نستطيع حينها أن نوظّف طاقاتنا في مجالات أخرى. إنّ الحياة متعة ومعاناة؛ ولأننا سنمرّ جميعاً بفترات مؤلمة فلنتعلّم إذاً التعايش معها دون السعي وراء سعادة وهمية.