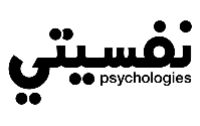ذهول، لامبالاة ظاهرية، صعوبات في التعلم، سلوك خطر وإدماني؛ تلك صفات تظهر على الطفل الذي تعرض للعنف أو لا يزال يتعرض له. تشرح لنا الطبيبة “ميوريل سالمونا” تبعات الصدمات النفسية التي يسببها العنف الجنسي على الأطفال، وآليات التعامل مع الصدمات وكيفية التعافي المحتملة منها حتى بعد مرور سنوات.
“ميوريل سالمونا” طبيبة ومعالجة نفسية ورئيسة “جمعية ذاكرة الصدمات وعلم الضحايا” (Traumatic Memory and Victimology Association).
ما هي آليات التعامل مع الصدمات التي يتبعها جسم الطفل عند تعرضه للعنف الجنسي؟
“ميوريل سالمونا”: أولها الذهول؛ عندما يتعرض الطفل لعنف مروع وعصيّ على فهمه يجد نفسه مشلولاً عقلياً وجسدياً. اللوزة الدماغية هي التي تفعّل هذه الحالة، فهي بمثابة جهاز إنذار داخلي يجعل الجسم ينتج هرمونات التوتر (الأدرينالين والكورتيزول)، والغاية منها تزويد الجسم بـ “الوقود” (الأكسجين والغلوكوز) اللازم لتهيئه للفرار أو المقاومة. لكن المشكلة أن جهاز الإنذار هذا لا تعدله أو تخمده إلا القشرة المخية حصراً، فأما البالغون يستطيعون إخماده من خلال تحليل الموقف الذي يتعرضون له ومحاولة فهمه واتخاذ قرارات بشأنه، وأما الأطفال الذين لم تنضج قشرتهم المخية تماماً بعد فلا يتوقف هذا الإنذار المدوّي داخلهم.
هل يُحتمل أن تشكل آلية النجاة هذه خطراً على الجسم؟
يجد الجسم نفسه بحالة توتر حاد وتصل فيه الهرمونات إلى مستويات سامة تمثل خطراً حيوياً على القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي. ولكي يتدارك الجسم هذا الخطر يتبع آليةً مشابهةً لتلك المتّبَعة في الدارة الكهربائية التي تتعرض لجهد زائد؛ إذ يقطع الدماغ الدارة العاطفية بالاستعانة بالنواقل العصبية التي تعد “مخدرات قوية” تتسبب بتخدير الإنسان وانفصاله عن الواقع (تأثيرها يماثل تأثير أدوية المورفين والكيتامين وهرمونات الإندورفينات وأدوية مثبطات مستقبل “إن-ميثيل-دي-حمض الأسبارتيك” الذي يُختصر بـ (NDMA))، فيدخل جسم الطفل في حالة تخدير عاطفي وجسدي وإحساس بالانفصال عن الواقع والغرابة والتغيب، توحي للطفل بأنه مشاهِد خارجي لما يجري فقط وكأنه يشاهد فيلم. انقطع الرابط مع القشرة المخية، وأُخمدَت الاستجابة العاطفية؛ هذا ما يطلَق عليه الانفصال عن الواقع.
للأسف فانفصال الضحية عن الواقع يسمح للمعتدي بأن يكون هادئاً.
في الواقع؛ إن عدم إصدار الضحايا الذين شُلَّت استجابتهم لأي إشارات استغاثة يعرضهم للوم بعبارات مثل: “لماذا لم تصرخ، لم تهرب، لم تقاوم، لم تُظهر أي رد فعل؟”. يتحول انفصال الضحية عن الواقع إلى مصيدة لها، فقد تزداد تصرفات المعتدي العنيفة قساوةً أكثر فأكثر دون أن يتمكن الضحايا من الرد. عندما يخدَّر الضحايا تزداد عتبة مقاومتهم للألم، وأكثر ما يتجلى هذا في حالات الاغتصاب الجماعي للفتيات المراهقات اللواتي إما لا يتجاوبن أو يتصرفن كالإنسان الآلي. والأسوأ من ذلك، وبما أن الانفصال يحول الضحية إلى إنسان آلي؛ يتمكن المعتدي من فعل ما يحلو له ويستطيع بسهولة إجبار الضحية على أن تشارك في العنف الممارَس عليها ويكرر عبارات تعبر عن قبول الضحية الزائف لما يجري (“قل لي أن ما أفعله يعجبك، وأنك ترغب بحدوثه”)، ليحاجج لاحقاً أن الطفل قبِل بذلك. تذكر أن الأحكام القضائية فقط هي التي تسمح بعدم احتساب مبدأ القبول عند الأطفال دون سن الخامسة، فعندما يبلغ عمر الطفل ست سنوات لن يحق له الذهاب إلى الطبيب بمفرده؛ لكن يمكن أن يتعرض للاغتصاب من ابن عمه ويُعد شريكاً في ذلك. هذا لا يُعقل!
إلى متى يستمر الانفصال عن الواقع الناتج عن الصدمة؟
قد يستمر لساعات أو أيام أو شهور أو حتى سنوات إذا ظل الطفل يعاني من العنف أو بقي على صلة بالمعتدي وشركائه. يبدو الطفل بعد أن تخدرت عواطفه غير مبالٍ ومنفصلاً عن ما حوله دائماً، لهذا يُحجم العديد من الضحايا عن تقديم شكوى أو يقدمونها بعد فوات الأوان وفقاً لفترة التقادم، وهذا يفسر أيضاً التلقي الخاطئ لمعاناة الضحية من قبل الأقارب والخبراء في معظم الأحيان، فعندما يتعاملون مع ضحية منفصلة عن الواقع لا يستطيعون تصور مشاعرها من خلال “شبكة العصبونات المرآتية” لديهم. لذا فإن الطريقة الوحيدة ليعرفوا معاناة الضحية تكون فكريةً؛ أي بالتفكّر في معاناة الضحية بغض النظر عن المشاعر التي تُظهرها والتي قد تشير لمن يراها دون تمعّن فيها إلى الفراغ والعدم والغموض لديها. لذا يفتقر تعاملهم معها غالباً إلى التعاطف أو يتسم بالتشكيك أو الاستخفاف بحالتها أو حتى التشكيك الكلي في العنف الذي تعرضت له.
مجدداً يقع الطفل ضحية آلية النجاة التي يتبعها جسمه
بالتأكيد سيُنظر إلى الطفل بأنه ضعيف ومتناقض وعاجز عن فهم ما يحدث له وبالتالي عاجز عن إبداء أي رد فعل عليه، وسيكون عرضةً للسخرية والإهانة وسوء المعاملة. وكان خير تمثيل لهذه الفكرة مشهد في فيلم “الملمِّعات” (Polisse) الذي تجبَر فيه فتاة مراهقة يافعة على فعل تصرفات خادشة للحياء مع عدة فتيان لاستعادة هاتفها المحمول. لقد بدت غير مبالية بما حدث لدرجة دفعت الشرطة إلى السخرية منها: “ماذا كنتي ستفعلين إذاً لو أخذوا منك حاسوبك المحمول؟” فضجت صالة السينما بضحكات الحاضرين.
ما التأثيرات النفسية التي يمر بها الضحايا في الأيام والأسابيع والسنوات التي تلي الاعتداء؟
تتحول حياة الضحايا بالكامل إلى جحيم؛ إذ تطاردهم الذاكرة الصادمة وتمنعهم من أن يكونوا على طبيعتهم بوعي أو دون وعي منهم، ويخلطون كل الأمور ببعضها دون تمييز أو تحكم. لذا فإن عجز الضحية عن التمييز أثناء تعرضها للعنف يمنعها من التفريق بين الفعل الذي يصدر عنها والذي يصدر عن المعتدي عليها، ومن الشائع بكثرة أن تشعر بالرعب الذي يجتاحها مترافقاً مع شعورها بالإثارة والمتعة المنحرفتين اللتين يشعر بهما جلادها. وبالمثل، فإنها تعجز عن أن تدافع عن نفسها عندما يوجه إليها المعتدي عباراته الإجرامية (“يعجبك ما يحدث لك”، “هذا ما تستحقه”). وكلما تعرضت الضحية للعنف في مرحلة مبكرة ترسخ خليط المشاعر غير المفهوم هذا فيها.
لماذا لا نتعرف على أنفسنا بعد ذلك الحدث المؤلم؟
تشعر حينها الضحية أن لا قيمة لها وتخاف من كل شيء حولها، وتنفصل عن الواقع كي تنجو، وتجد أنها مغيبةً عن نفسها، وتحس أنها مذنبةً فتشعر بالعار من نفسها وتظن أنها تستحق الموت (مذنبة لارتكاب جرم نفذه المعتدي وصار جزءاً منها في النهاية لأنه يتكرر دون توقف في رأسها)، وترى أنها شخص منحرف قد يصبح عنيفاً ويجب السيطرة عليه باستمرار. قد تصير الحياة جحيماً عند الإحساس بانعدام الأمان والخوف والحرب الدائمة.
هل يفسر ما سبق ذكره إصابة الضحايا بالرهاب وأمراض الوسواس القهري والمخاوف؟
حتى يتحاشى الطفل أي شيء قد يعيد إلى ذهنه ذكرى صادمةً لا يطيق تذكرها يلجأ لسلوكيات متمثلة بالتحاشي واليقظة المفرطة والسيطرة، وقد تتجلى هذه السلوكيات على هيئة رهاب أو وسواس قهري مثل التنظيف المتكرر أو التحقق المتواصل مما يحيط به في محاولة منه لطمأنة نفسه من خلالها، وكثيراً ما يخلق لنفسه عالماً موازياً يكون ملاذاً له يشعر فيه بالأمان: مثل حجرة أو غرفته أو عالم خيالي. والمشكلة أن هذه السلوكيات ليست فقط منهكةً وتتغلغل في الطفل فتؤدي إلى ظهور اضطرابات معرفية لديه تؤثر سلباً في تحصيله العلمي والدراسي؛ بل غالباً يحبطها المحيطون به، إضافةً إلى أنها عديمة الفعالية في مقاومة قوة الذاكرة الصادمة. لذا يعتمد الطفل سلوكيات تحافظ على انفصاله عن الواقع حتى يمنع تلك الذكريات من الاندفاع إلى ذاكرته.
هل يبدأ الطفل تعاطي المخدرات والكحول عندما يبلغ تلك المرحلة؟
نعم. يفعلون ذلك لتخدير أنفسهم، كما يخلق الأطفال لا إرادياً مواقف عصيبة ويزيدون صعوبتها بمرور الوقت ليزيدوا كمية المخدر الذي يفرزه الجسم من خلال اعتمادهم سلوكاً إدمانياً (مثل إدمان المخدرات أو اضطرابات الأكل أو غيرها) أو إيذاء أنفسهم (بالضرب أو العض أو التجريح أو غير ذلك) أو تعريض أنفسهم للخطر (مثل ممارسة الرياضات أو الألعاب الخطرة أو سلوك جنسي خطر أو حالة اعتداء متكرر أو غيرها) أو ممارسة العنف اتجاه الآخرين. لكن هذه المشكلة من شقّين: فمن ناحية تعيد هذه السلوكيات إلى ذاكرة الطفل الذكرى الصادمة فتجعل لجوءه إلى السلوكيات الانفصالية أكثر ضرورة، ومن ناحية تقلّ فاعلية المخدرات التي يطلقها الدماغ كلما لجأ الأطفال إلى هذه السلوكيات فيضطرون إلى التمادي فيما يفعلونه لتحريض دماغهم على زيادة إفراز هذه المخدرات. فتكون هذه السلوكيات التي يستغربها المحيطون بالضحايا سبباً في انعزالهم، فيبدون غير مبالين أكثر فأكثر لأنهم منفصلون عن الواقع، وتقل فرص إنقاذهم. يا لها من حلقة مفرغة!
عندما يبوح القاصرون بتجربتهم المريرة يجازفون بألا يصدقهم الناس ويلوموهم ويسيئوا معاملتهم.
في معظم الأحيان يلجأ البالغون إلى أسلوب الخطاب الأخلاقي الذي يُشعر الضحية بالذنب. مثلاً أتذكر فتاةً صغيرةً فعلت تصرفات خادشةً للحياء في مكان عام، فوبخها جميع من رآها وأخبروها أنه لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، وأن تصرفها كان فظاً؛ وإنما كان عليهم أن يسألوها ببساطة: “من فعل هذا بك؟” وبهذا يكونون قد حددوا الجاني الحقيقي. أو مثلاً يبدون ردة الفعل نفسها عندما يجرح مراهق نفسه أو يحاول الانتحار، وكان حرياً بهم بدلاً من أن يُشعروه بالذنب أو يلقوا محاضرةً على مسامعه أن يسألوه كم هو شديدٌ العنف الذي عاناه حتى يشعر بهذا الألم.
هل يفتقر الضحايا القاصرون للمصداقية بنظر الناس؟
ينطبق هذا على جميع ضحايا العنف الجنسي، وخاصةً القاصرين منهم. وبدلاً من أن تكون الأعراض التي تظهر عليهم بسبب ما عانوه مرتبطة بالعنف والصدمة النفسية؛ تُستخدم ذريعةً لتوجيه أصابع الاتهام إليهم. عندما يرى من حولهم أن حالتهم سيئة يتهمونهم بأنهم أطفال صعبو المراس ومضطربون وغريبو الأطوار وجبناء وخجولون، كما يتهمونهم بأنهم يعانون من اضطرابات سلوكية واضطرابات في الشخصية وإعاقات ذهنية وأعراض نفسية وغيرها. يعتقد 95% من الضحايا أن العنف أثر في صحتهم العقلية، وإن جعل هشاشتهم النفسية وبالاً عليهم يُعد تصرفاً مؤذياً وقاسياً ومنافياً للمنطق، وخاصةً بوجود دليل طبي على مصداقيتهم. أما عندما يبدو أن حالتهم ليست بهذا السوء لأنهم منفصلون تماماً عن الواقع ومخدرون عاطفياً، يُستهان بالعنف الذي تعرضوا له أويشكَّك فيه.
هل قد يوجّه الأطفال اتهامات باطلة؟
تمثل الادعاءات الباطلة أقل من 6% من إجمالي الادعاءات المقدَّمة، ولن تجد واحدة منها مقدَّمة من طفل. ومع ذلك يظن الجميع أن ادعاءات الأطفال الباطلة شائعة، لذا يُحجمون عن الإبلاغ عندما يشكّون في وجود خطب ما. إنها آلية إنكار قوية في مواجهة ما لا يستطيعون تصوره، وهي الآلية ذاتها التي ترافق ما يسمى بـ “متلازمة النفور من أحد الوالدين” أو “نظرية الذاكرة الزائفة”. متلازمة النفور من أحد الوالدين ابتكرها طبيب نفسي أميركي أعماله مثيرة للجدل، و”نظرية الذاكرة الزائفة” كانت وصفاً لتفشٍ مزعوم لبلاغات تستند إلى ذكريات زائفة زرعها معالجون في رأس من قدّمها؛ والذي نشر في مجلة “فوغ” (vogue) في نهاية التسعينيات في الولايات المتحدة، وفي الجهة المقابلة ومنذ ذلك الحين أظهرت مجموعة مبهرة من الدراسات العلمية أن الذكريات المسترجَعة موثوقة.
هل يُعقَل أن ينسى المرء أنه وقع ضحيةً للعنف الجنسي؟
قد يبدو هذا مفاجئاً حقاً لكنه آلية فيزيولوجية؛ إذ يعد انفصال القشرة المخية أيضاً منشأ اضطرابات الذاكرة. تنقطع الدوائر المتكاملة؛ ما يؤدي إلى فقدان ذاكرة مؤقت لفترات زمنية متفاوتة (عند 59% من ضحايا الاعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة) أو فقدان ذاكرة كلي (عند 38% منهم). وكلما كانت الضحية أصغر سناً وكانت درجة قرابة المعتدي منها أكبر اشتد فقدان الذاكرة، وقد يستمر هذا النسيان لعقود أحياناً، إلى أن تعود الذكريات إلى الضحية غالباً فجأةً ودون سابق إنذار وبتفاصيل كثيرة ودقيقة ويصاحبها إحساس بالضيق والرهبة والذهول وأحاسيس أخرى بغيضة.
كيف نفسر هذه العودة المفاجئة للذكريات والأحاسيس بعد أن كانت طي النسيان لمدة قد تصل إلى عقود أحياناً؟
هذا مرتبط بذاكرة الصدمات. عادةً تكون بنية الدماغ التي تسمى الحُصين هي المسؤولة عن جمع الأحداث التي مرّ بها الإنسان وتحويل الذاكرة العاطفية إلى ذاكرة السيرة الذاتية التي يمكن تذكرها والتعبير عنها؛ لكن عندما يتعثر عمل الدماغ تتحول الذكريات العاطفية التي لم يعالجها الحُصين إلى ذكريات صادمة تكون ذكريات “وهمية” مبهمة ومفرطة الحساسية ولا يمكن التحكم فيها؛ مثلها كمثل “الصندوق الأسود” الذي يبقى فعالاً. نتيجةً لذلك يعيش الضحايا في ظل خوف وألم ويأس دائم، كما أنهم يعانون من إحساس مفاجئ بأن خطراً كبيراً يحدق بهم أو أنهم محطمون أو مصدومون أو فاقدون للوعي أو يحتضرون أو أن رؤوسهم أو أجسادهم تؤلمهم بشدة أو أنهم يختنقون أو غير ذلك.
ما الذي يحرض الذاكرة الصادمة ويعيد الذكريات المؤلمة إلى الذهن؟
قد تتوالى الذكريات المؤلمة نتيجة خروج الضحية من حالة الانفصال عن الواقع، ويحدث هذا مثلاً عندما تشعر الضحية في النهاية بالأمان أو عندما تعاني من عنف شديد لدرجة يعجز فيها جسمها عن إدخالها في حالة انفصال أو إبقائها فيها أو عندما يذكّرها موقف أو إحساس أو ضوء أو رائحة معينة بالعنف الذي تعرضت له أو يجعلها تخشى تكرار حدوثه. قد تستيقظ الذاكرة الصادمة مجدداً بعد شهور أو حتى سنوات من سباتها لتُبعث في ذهن الضحية وكأنها تعيش الأحداث والعواطف والأحاسيس التي مرت بها من جديد بنفس الرهبة والألم.
كيف يتحرر الضحايا من هذا الجحيم؟
لتلافي حدوث هذا يجب إعادة معالجة الذاكرة الصادمة وتحويلها إلى ذاكرة السير الذاتية ويجب أن نطهّر الدماغ من خليط المشاعر الذي يضره. يتحقق ذلك بـ “مراجعة” الضحية لتجربة العنف التي مرت بها ويرافقها أثناء ذلك مختص محترف فتتحدث خطوةً تلو الخطوة عن كل موقف وسلوك وإحساس عاشته، فيُجري تحليلاً دقيقاً لسياق حديثها وردة فعلها وسلوك المعتدي عليها؛ ما يسهل خروجها من حالة الانفصال عن الواقع. إنها مسألة إعادة إضفاء التسلسل الزمني على الأحداث وإنشاء روابط بينها والشرح للمريض عن آليات الدماغ في التعامل مع الصدمات وإعادة التوازن إلى حياته. لا حاجة لوصف أدوية له إلا لتخفيف المعاناة والتوتر عند اشتدادهما (مضادات القلق حسب الحاجة، ومسكنات وحاصرات بيتا لتقليل إفراز الأدرينالين)، فيرمَّم الضرر العصبي تدريجياً ولا تبقى حاجة لاستمرار اتباع الجسم لاستراتيجيات النجاة. كل ما ذُكر يستغرق وقتاً ويجب تنفيذه بوتيرة تحددها حالة المريض، مصحوباً بتلقيه العلاج النفسي، فمن الخطير اليوم الاكتفاء بعلاج المرضى بوسائل علاجية مثل التنويم المغناطيسي أو “إزالة الحساسية وإعادة المعالجة عن طريق حركة العين” (EMDR) أو “العلاج المعرفي السلوكي” (CBT) دون أن تقترن بأساليب العلاج النفسي طويلة الأمد. بالطبع تلك الوسائل عملية وسريعة التطبيق وغير مكلفة لكنها قنابل موقوتة مؤقتة.
هل تفاقم بعض العلاجات النفسية أعراض الصدمة؟
نعم عندما لا يتيح العلاج للضحية سرد قصتها تدريجياً حتى يُتاح الدماغ تحليلها حسب وتيرته الخاصة؛ إذ لا يؤدي ذلك إلى اجتياح المشاعر ذاتها للمريض من جديد فحسب بل يجعلها تعزز انفصاله عن الواقع أيضاً، وهذا أصلاً ما يجيد الضحايا فعله دون تلقي المساعدة من خلال استماعهم إلى موسيقى صاخبة جداً أو تمسكهم بألعاب الفيديو العنيفة أو تخدير أنفسهم بالمخدرات أو الكحول، فأنت لا تحتاج إلى مساعدة معالج نفسي لتفعل ذلك.
هل يمكن أن يفوت أوان التعافي من الصدمة؟
كلما تلقت الضحية العلاج في المراحل الأولى (خلال 12 ساعة في الحالة المثالية) كانت الصدمة أقل وطأةً. ومع ذلك، وحتى بعد مرور سنوات؛ يمكن علاج الذاكرة الصادمة و”التعامل مع الصدمات” ورأب الجرح النفسي الأولي ليتحرر منه المرء في النهاية ويستكمل السير في درب حياته. يجب علينا أن نتبع المقولة اللطيفة للمحللة النفسية “أليس ميللر” بأن: “نحطم جدار الصمت الذي يحبس الطفل المنتظِر بلهفة خلفه ونضمه إلينا”.