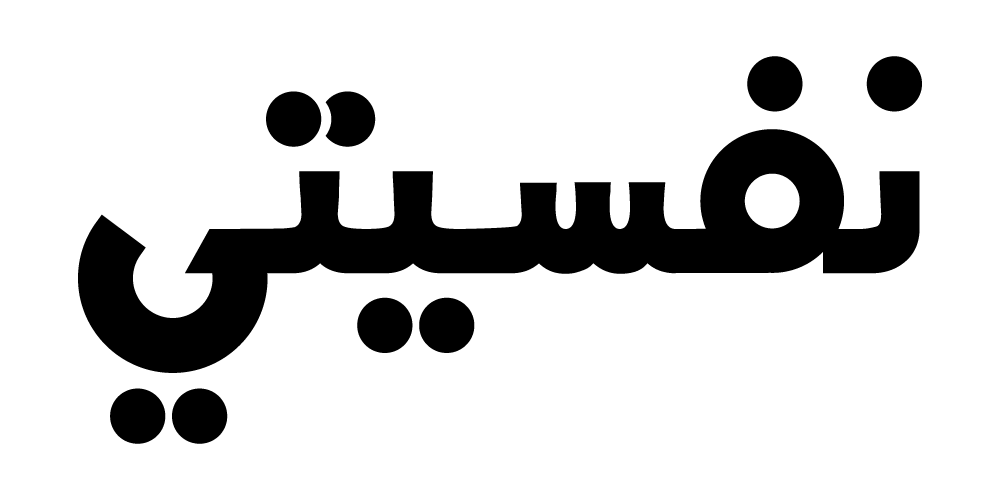العلاقات السامة هي تلك التي تستنزفنا ولا تترك أرواحنا إلا وهي محطمّة، وربما لا جلّاد فيها ولا ضحية لكن الأذى يتولّد نتيجة لقاء شخصيتين تنتمي كلّ واحدة منهما إلى عالم مختلف. نغوص في هذا المقال داخل هذه العلاقات لنستكشف ما يحصل ونتعرف إلى كيفية النجاة من الشخصيات السامة.
استمرّ زواجي الأول قرابة السّنة، وفي تلك السنة تقبّلتُ التعايش مع ما لم يطُف بخيالي ولا لوهلةٍ أني سأتقبله يوماً؛ كالإدمان والإهانة والتهديد والحطّ من قدري على الملأ. قضيتُ سنةً كاملة أعاني من ضيق الصّدر؛ سنةً في محاولات إنهاء هذه المأساة وكنت أستسلم طواعيةً في كل مرة وأبدأ من جديد. كنتُ مفتونة بزوجي وواقعة في غرامه، وكان يغمرني شعور في البداية أن وجودي معه يفتح عينيَّ على الحياة والعالم غير أن علاقتنا بدأتُ شيئاً فشيئاً في التلاشي إلى أن ضعفت تماماً ولم يعد هناك إمكانية للاستمرار فيها. لكن الآن وبعد أن ابتعدت عما كان يحصل، اكتشفت أني كنتُ أملك الأسباب التي تجعلني فريسة سهلة؛ كنت منتشية ومغيّبة ومبتهجة أني حظيتُ بفرصة مشاركة الحياة مع شخص غامض ورائع مثله، رجل حاد الذكاء ومتميز يعرف كيف يتلاعب بالكلمات لتصبح سحراً يخدّر العقل. يفعل ذلك وهو يخبرني كيف سيتحوّل وجوده إلى جحيم إن لم يجدني إلى جواره وأن لا حياة له من دوني. اليوم حتى بعد مرور ثمانية أشهر على انفصالنا، ما زلت أجد صعوبة في إقفال الأبواب كلّها أمامه واتخاذ قرار لا رجعة فيه. أجد نفسي أتخبط في بحر من الحيرة حيث سؤال يسلّمني لسؤال: هل كان منحرفاً نرجسياً؟ هل كنت واقعة تحتَ سحره؟ هل كان يتلاعب بي؟ تعجز الكلمات عن التعبير عما كنت أجده في هذه العلاقة. غير أني متأكدة من أمر واحد؛ إن اختلاف شخصية كل واحد فينا كان الشرارة التي ولدت هذه العلاقة المسمومة، بكل ما فيها من اختلافات تفرقنا عن بعضنا، وأيضاً بكل ما يجمعنا من معاناة مشتركة تعود للماضي والطفولة، فمن الصعب بمكان أن تضع يدك على المسؤول في "هذه العلاقة السامةّ". شهادة مرام هذه تلخص الإشكالية بشكل وافٍ بين شريكين في علاقة حبّ ضمن مؤسسة الزواج، أو بين أفراد الأسرة تحت سقف واحد، أو في بيئة العمل أو في الصداقة، فلا مكان على الإطلاق يجد فيه الإنسان نفسه في مأمن من الوقوع في شباك علاقة تستنزف روحه إلى آخر قطرة، غير قادر ولا راغب في الفكاك منها أو حتى تحسينها. لكن من المتسبب الأول في ذلك؟ شخصية الطرف الآخر؟ شخصيتنا؟ أم لقاء شخصيتَين من الأفضل ألا تلتقيا من الأساس؟
صحيح أن هناك بعض المفاهيم النفسية الرائجة على وسائل الإعلام وتحاول شرح السبب، وصحيح أن كتب الطب النفسي أفردت مكاناً لوصف الشخصيات السامة بشكل واضح وصريح غير أن هذه الشخصيات السامة تظلّ الاستثناء لا القاعدة في حياتنا، وليس في كل أرجاء حياتنا كما يتمّ تصوير الوضع اليوم في وسائل الإعلام. لكن ما فتح الباب على مصراعَيه لانتشار هذه الأوصاف على كل لسان هو وصف "المنحرف النرجسي" الذي راج إعلامياً بعد ظهور كتاب "الانحرافات النرجسية" (Les Perversions narcissiques) لبول كلود راكامييه (Paul-Claude Racamier) والذي كان له السبق في الجمَع بين مفهوميّ "الانحراف" و"النرجسية". حين نكون في علاقة مؤذية، فمن الطبيعي أن نلوم الطرف الآخر ونصوّره وحشاً، ونحن نفعل ذلك أكثر بكثير من مساءلة العلاقة أو حتى أنفسنا! يقول مؤلف كتاب "أقوال منحرفة" (Paroles perverses) والطبيب النفسي روبير نوبورغر (Robert Neuburger): "ضاق قضاة محكمة الأسرة ذرعاً بالنظر في قضايا الطلاق التي تتذرع بـ "الانحراف النرجسي". إن استعمال هذا المصطلح بشكل مبالغ فيه ودون ضوابط يفرِغه من معناه، وهو ما حصل سابقاً مع المبالغة في استعمال مصطلح الاحتراق الوظيفي (burn-out)، فهذه المبالغة التي تفرغ المفاهيم النفسية من معانيها بالغة الخطورة، ذلك أن ثمة "احتراقات وظيفية" حقيقية و"منحرفين نرجسيين" حقيقيين يمكن أن ينسلّوا داخل هذه الفوضى العارمة التي تحصل، فيختلط الحابل بالنابل". ولا يتوانى شباب اليوم في تصنيف أيّ شخص يتسبب لهم بالضيق بالمنحرف النرجسي، وفي هذا الصدد تقول منى البالغة من العمر 26 سنة ضاحكةً: "أنعت حتى السيدة التي أخذت مكاني في طابور الانتظار في مصلحةٍ ما بهذا الوصف"، رغم أن منى نفسها خارجة للتو من علاقة مدمرة استمرت زهاء السنة واختبرت بنفسها مرارة العيش أو التعامل مع "المنحرف النرجسي" الحقيقي.
أعراض تتوزع بين القسوة والحزن والصمت
يوضح الطبيب النفسي قائلاً: "ينبغي لنا التمييز بين الشخصية المنحرفة التي تجد متعتها في التلاعب بالآخر وإيذائه، وبين السلوكيات المنحرفة التي يمكن أن نتسّم بها جميعاً في سياق ما ولأسباب مختلفة. فلنأخذ على سبيل المثال الكذِب؛ لا شكّ في أنه يُعد شكلاً من أشكال التلاعب لكنّ إقدامنا عليه لا يجعل منا بالضرورة كاذبين ولا منحرفين، غير أن الأضرار التي يتركها في الحالتين بالغة. ثمة أشخاص إذاً يلتجئون إلى استعمال تقنيات منحرفة أكثر مما يفعل المنحرف الحقيقي، ولهذا فإن أي تلاعب هو مؤذٍ وسامّ بصرف النظر عمَّن صدر منه، وعليه يمكن أن ننعتَ بالـ "سامّ" أو "المؤذي" أي تصرفّ أو سلوك يؤثر في الآخر نفسياً بالسلب، والمعيار هنا هو قياس إلى أيّ مدىً هو مَرضيّ"، فأعراضه واضحة وتتوزع بين العنف والحزن والصمت. يُعد انقباض النفَس والغصة أول ما يشعر به الشخص حين يجد نفسه في مكان واحد مع الشخص المؤذي أو حين يغادره، بالإضافة إلى أعراض أخرى كالدوخة وفقدان الشهية حيث لا تنبغي الاستهانة بالأعراض الجسدية التي من شأنها أن تكون جرس إنذار تطلقه أجسادنا لتنبهنا إلى أننا لم نعد نريد أو نستطيع مواصلة الانجرار خلف هذه العلاقة. يأتي الحزن بعد ذلك كعرَضٍ ثانٍ، حين يرمي بثقله على النفس والجوّ مصاحَباً بفقدان الثقة في النفس والاكتئاب. فصفة هذه العلاقات وهي "سامّة" تعني حرفياً ما يسمّم ويدمرّ ويودي بنا إلى التهلكة، غير أن البعضَ يظن أنه "البطل الذي سيجد ترياق السم"، ولا يلبث هذا الاعتقاد أن يتكسّر على صخرة الحقيقة.
رقصةُ الموت
في جملته الحوارية: "لم تكن المشكلة في أحدنا، لا فيكِ ولا فيّ أنا؛ المشكلة فينا ونحن معاً"، يلخص طوني بطل فيلم "مَلِكي" (Mon roi) ما يحصل في هذا النوع من العلاقات إذ يتناول الفيلم قصة شخصين يقعان ضحية حبّ مجنون حيث لا يستطيعان الفكاك من شراكه ويستمران في تدمير بعضهما بعضاً. وتشير المعالجة إلوِيز بوتيجون (Éloïse Petitjean): "في معظم الأحيان، العلاقات السامة هي تلك التي تكشف عيوب الفرد عن عيوب شريكه"، ويضيف جوناثان سانسوز (Jonathan Sansoz): "نحن نقوم برقصة قاتلة، فحين نبحث عن حلّ للعلاقة المؤذية نعمد إلى توجيه أصابع الاتهام إما إلى الآخر أو إلى أنفسنا على اعتبارنا أصل المشكلة في حين أن العلاقة نفسها هي منبع الخلل، أما الحديث عن عيوب الطرفين فيأتي من باب إلصاق التهمة بهما دون وجه حق". هل يتعلق الأمر بلقاء تراجيدي جمع بين شخصين لا تصفان بالوعي؟ أم أن الأمر عبارة عن خيار مدروس نقوم به؟ تتساءل منى حائرةً: "ما زلت إلى يومنا هذا أجهل إن كان غسان شخصاً متلاعباً حقاً غير أني أدركت أني خضت معه هذه التجربة منساقة خلف نداء يعود بجذوره إلى طفولتي البعيدة، فطريقته في الحطّ من قدري والتقليل من احترامي توافق نقصاً في الثقة لديّ، وطريقته في مدّي بمشاعر الحب ثم استعادتها تدفعني إلى الإيمان بأنه لا يحبني، وتجدُ صداها في نمط واضح تكرر في طفولتي أفضى إلى إيمان راسخ لديّ بأنّه ما من أحدٍ يمكن أن يحبني في هذا العالم. شخص آخر غيري ما كان بالتأكيد ليقبل هذا كلّه؛ تماماً كما رفضتُ أنا بدوري ذلك لاحقاً في مرحلة أخرى من حياتي. لكني حتى قبل أن أدخل هذه العلاقة عشت النمط نفسه من العلاقات مع رئيسي في العمل، فيما الشخص الذي حلّ محلي مباشرة بعد استقالتي لم يواجه معه أدنى مشكلة".
حين تقف العلاقة أمام طريق مسدودة، فالعلاقة هي السبب!
لا ينبغي إشعار الطرف الضحية في العلاقة بالعار والذنب؛ يكفيه ما يلاقيه من نفسه وهو عالق في دوّامة تقريع الذات وتحميل النفس مسؤولية ما يحصل مسكوناً بصوت لا يتوقف يردد: "أنا السبب". وعلى العكس من ذلك، ينبغي تحفيزه ليتحرك ويصير فاعلاً بدلاً من اكتفائه بأنه ردة فعل! لا تتحرك عجلة أي علاقة إلا بوجود شخصين اثنين لكن باحتساب العلاقة نفسها كطرف يصيرون ثلاثة؛ ما يوفر منظوراً آخر لحلّ الأزمات يتجاوز إلقاء اللوم على الآخر. توضح إلويز بوتيجون: "أول ما يفكر فيه الشخص حين يكتشف وجود طرف نرجسي في العلاقة هو إنهاء هذه العلاقة على اعتباره يعيش مع وحشٍ كاسر لا رحمة في قلبه والحلّ الوحيد هو الهرب منه، فيما الحقيقة أنّ بالإمكان دائماً الاشتغال على العلاقة لكن على ذلك أن يمرّ أولاً باشتغالٍ جاد على الذات. إن ما يلحق الضرر بك ليس النرجسي؛ بل مواصلة العلاقة معه! عند توقف العلاقة، يمكنك مواصلة الحياة مع شخص آخر. أنت لست مجبراً أن تكون موضع الضحية، استأنف حياتك دون هذه العلاقة. .