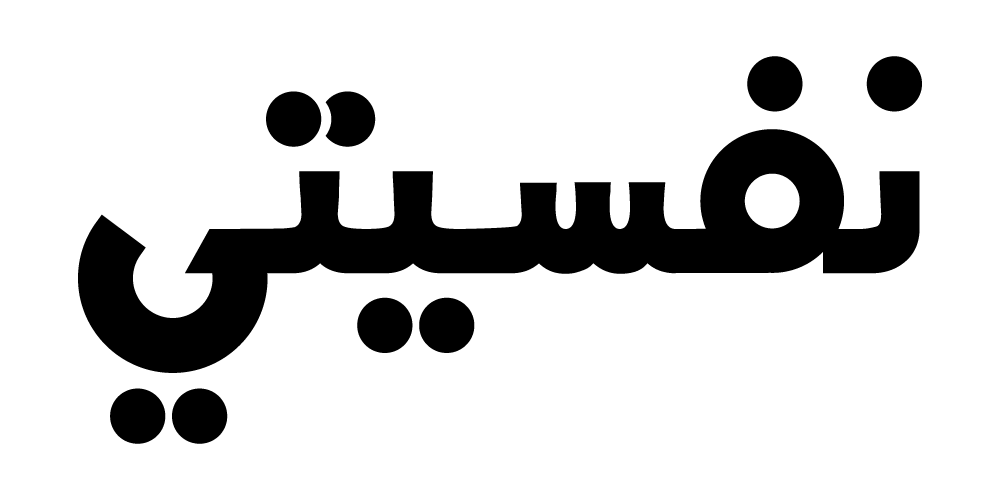زادت وتيرة تردّد أشخاص "لا يواجهون أي مشكلة" على عيادتها؛ ما دفع بها إلى التساؤل: ما الذي أتى بهم إلى عيادات العلاج النفسي؟ تصف عالمة النفس والمعالجة النفسية الفرنسية إيناس فيبير، توافد نوع جديد من المرضى إلى عيادتها متمثل برجال ونساء يبحثون عن معنىً وروحانية لوجودهم، وتطلق عليه اسم "المُتعطّشين الجُدد" (Les Nouveaux Aspirants). تجد المعالجة النفسية في تردد هذه "الأرواح الهائمة" إلى العيادات النفسية، دعوة صريحة للمعالجين لإعادة النظر في مناهج المرافقة النفسية التي يقترحون.
مشكلات الأغنياء
اليوم وبوتيرة متزايدة، صار يدق أبواب عياداتنا، نحن المعالجون النفسيون بتخصصاتنا المختلفة، أشخاص "لا يواجهون أي مشكلة" بالمعنى المتعارف عليه للمشكلة. المفارقة أنهم أكثر الأشخاص شكوى، والأمر عائد إلى أنهم لا يجدون أي أزمة حقيقية في حياتهم تُبرر ما ينتابهم من شعور قوي ومسيطر يختلط فيه عدم الرضا العميق بالإحباط الهائل، فهم يمارسون مهنة اختاروها بكامل إرادتهم وتبدو كما لو فُصِّلت لأجلهم، ويعيشون حياة عاطفية مُفعمة بالحب مع شريكٍ يلائم ذوقهم ويتوافق مع طموحاتهم، ويحيطون أنفسهم بأصدقاء أوفياء وأسرة داعمة؛ كما يملكون هواياتٍ مختلفة تسمح لهم رفاهية الوقت والمال بممارستها. إذا كان لديهم هذا وأكثر، فماذا يفعلون في عياداتنا؟ فهم لا يتوانون عن إبداء انزعاجهم من عدم وجود أي مأساة حقيقية يخبروننا بها، والتعبير عن ضيقهم من إحساسهم بالذنب لتعدادهم متاعب صغيرة حتى لو جُمّعت ببعضها لن تصنع مشكلة. يصفها البعض بـ "مشكلات الأغنياء المزيفة"، فيما يجد فيها البعض مبررات واهية تُساق بغرض التلاعب باللاوعي كي يتوهم أنهم يخبّئون في جعبتهم سراً أكبر يجب أن ننبش لاكتشافه. وبناءً على ذلك فقد نخطئ إذا قلّلنا من شأن معاناتهم هذه ولم نأخذها بالجدية اللازمة. شعورهم بعدم الرضا الذي يبدو للوهلة الأولى مُبهماً وطفيفاً هو ما سيفتح لنا الباب لاكتشاف أزمة جديدة يمكن أن نطلق عليها "الحالة النفسية المعاصرة" أو بشكل أدق "حالة النّفس المعاصرة".
البحث عن المعنى والبصمة الخاصة
وقفتُ على هذه الظاهرة عند مجموعة من الأشخاص أغلبهم في عمر الشباب. هل يتعلق الأمر هنا بمشكلةٍ خاصة بجيل دون غيره؟ إذ على الرغم من أن بعض العلماء السابقين لعصرهم من أمثال يونغ، شخّصوا منذ بدايات القرن العشرين عطباً روحياً شبيهاً بهذا يتعلق بالإنسان الغربي الحديث؛ فإن العطب الذي نحن أمامه الآن يبدو أنه يلمس طائفة أوسع وغير مسبوقة من الناس.
ولأن هذه الظاهرة استحوذت على تفكيري، فإني بعد تمحيص وتدقيق خلصت إلى استنتاج مفاده أن هذا النوع من الأشخاص لا يلجأ إلينا بحثاً عن حل لمشكلة يواجهها ولكن سعياً لإشباع عطش روحي. والفرق بينهما هائل كذاك الذي يفصل القوة عن الضعف، فمن جهة يتعلق الأمر بتَعطُّشٍ حركي؛ والمقصود هنا أنه يدفع بالمرء إلى سبر أغوار نفسه، وبلوغ الحد الأقصى من إمكانياته ككائن بشري، ومن جهة أخرى هي تطلعات تصنَّف بأنها "روحية" باعتبارها تستهدف تطوّر الذات، والبحث عن معنىً وحياة أكثر أصالة.
وكل هذا البحث ينبع من سؤال يُلحّ عليهم مفاده: "ما محلّي من الإعراب في كل ما حققت وأسَّست لحد الساعة؟ وحياتي هذه، هل تشبهني يا ترى؟". وبتعبير آخر: "هل وجودي الواقعي يتقاطع مع إرادتي في الحياة واحتياجات روحي الأعمق؟".
نصف حياة
إرادة الحياة
يشعر الكثير من الأشخاص اليوم بأنهم يعيشون دون بذل سوى القليل جداً بالمقارنة مع قدراتهم وكفاءاتهم العميقة كأن جزءاً لم يعرفوا بوجوده في أرواحهم قد تعرَّضَ للبتر. ولأننا في زمن لا يعترف سوى بما هو مادي ومنطقي عند البشر، فقد حُكم عليهم بالعيش بنصف حياة؛ بنصف وعي، ونصف إبداع، ونصف وجود، ونصف حبّ؛ ما يجعلنا في النهاية نصفَ إنسان، ذلك أن ما يمنح البشر وجودهم ليس ملء فراغ هذا الوجود بمراكمة المقتنيات والأعمال بل السكن داخله. أي، إذا صحّ التعبير: "أن تسكن نفسك!".
احتياجات عميقة
لا شكّ في أننا نملك حرية اختيار الحياة التي نريد؛ لكن من بيننا يملك الوسائل اللازمة التي تخول له ممارسة هذه الحرية بشكل كامل حقاً؟ كم من شخص يا ترى في وضع يسمح له بتحقيق اختياره في الحياة؟ ونحن هنا لا نقصد الأمر من وجهة نظر مُجتمعية تفرضها معايير خارجية مثل اتباع نموذج النجاح الشائع وتحقيق الأمان المالي وتلبية توقعات الآخرين؛ بل المقصود هنا ذاك الاختيار النابع من زخم الروح الذي يمليه علينا إلهام داخلي وحدسٌ لا يكذب.
حقيقة الوجود المخفية
أوْلى المعالج النفسي كارلفريد غراف دوركايم مبكراً اهتماماً خاصاً لما اعتُبر وقتها في القرن العشرين طفرة كبرى في نوعية المتوافدين إلى العلاج النفسي. إذ يقول:"الأشخاص الذين ألتقي بهم ليسو مرضى؛ إنهم رجال ونساء يبحثون عن ذواتهم الحقيقية". وإن لم يكن الأشخاص الذين يتابعون معه العلاج مرضى نفسيين، فإنهم على ذلك يقاسون معاناةً "تخصّ الإنسان المحكوم بالحضارة العقلانية" تسبَّب فيها "النظام المفروض من قِبَل المجتمع، باحتياجاته المحدودة وبوصلته الأخلاقية التائهة؛ والتي تتكاتف جميعها لغرض واحد وه أن تُخفي عن الإنسان حقيقته العميقة". اليوم، إزاء حالةٍ كهذه، ألا يزال صالحاً إحالتها أثناء محاولة تصنيفها إلى المصطلح الشامل "عصابي"؟ أم ينبغي لنا إعادة النظر في الأمر والإقرار بأننا أمام حالةٍ مختلفة عمّا اعتدنا تشخيصه بالاضطراب النفسي؟
هذا التوتر الذي يذكر المرء بنفسه ويدفعه إلى البحث عن علاجٍ لذلك يختلف عن التوتر الذي ينتج عن صراعات نفسية داخلية؛ بل إنه في رأيي ما أطلق عليه بيرغسون "قوة الخلق" (élan vital) أو ما سمَّاه سبينوزا "الجهد" (conatus). فهذا التوتر بشكله الذي يظهر على الأشخاص الذي نتحدث عنهم، أراه نتيجة حاجة مُلِحّة متأججة في كل إنسان، ألا وهي الحفاظ على وجوده؛ أي البحث الدائم عن أشكال الوجود التي تخول للإنسان وباستمرار التعبير بطلاقة عن حيوية ذاته العميقة وحقيقتها.
التعطش للقاء النفس
إن أي مرافقة تقليدية تكاد تكون دون جدوى بل وذات أضرار على هذا النوع من المرضى الذي أفضّل أن أطلق عليهم اسم "المتعطّشين"، فإذا كانت الطبيعة الروحية لهذا الطلب غير معترف بها في الميدان النفسي، فإن هذا يقودنا كمعالجين إلى فهمٍ وتشخيص خاطئَين لهؤلاء الأشخاص. ولأن ثقافتنا المعاصرة أهملت البُعد الروحي للإنسان باعتبار الحديث عنه دليل رجعية وسذاجة، فقد صرنا نواجه شُحّاً في عدد المعالجين القادرين على التمييز بين المعاناة الوجودية والشعور بعدم الاكتمال ذي الأبعاد الأنطلوجية والروحية. لكننا بالتأكيد نستطيع اعتبار الفروق الكلاسيكية التي حددها كارل غراف دوركايم بين الوجودي والأساسي، مرجعاً نعود إليه في هذا الصدد. إذ يوضح: "ينبغي التمييز بين نوعين من المعاناة؛ تلك التي ترتبط بالعجز عن أداء هذه الوظيفة أو تلك في العالم، والثانية التي تكمن في عدم القدرة على إيجاد ما يجمع المرء بنفسه؛ أي عدم القدرة على الشعور بالاتساق بين ما يرى عليه نفسه روحياً وبين ما يعيشه في الواقع". ثم يشرح بتفصيل أكثر: "فالمعاناة التي ترجع إلى عدم القدرة على أداء مهام المرء المنوطة به في العالم؛ كعدم القدرة على العمل والحب والتكيف، تلمس وجود الإنسان الطبيعي أي الوجودي"، فيما ترتبط المعاناة الناتجة عن عدم القدرة على تحقيق الذات الحقيقية بوجود الإنسان الأساسي. ولكل معاناةٍ المنهج العلاجي الذي يناسبها؛ واحدٌ يركز على مساعدة المرء على الانخراط في المجتمع والشعور بالتناغم أي الشعور أنه طبيعي وسط عالمه، والثاني يمَكِّنُ الشخص من الاتصال مع ذاته العميقة وعيش حياة تخدم غايته الكبرى في العالم، ألا وهي أن يجدَ ذاته. لكن هل يوجد اليوم معالجون يتحلّون بالبراعة الكافية التي تخول لهم تقديم هذا النوع الثاني من العلاج حقاً؟
نداء للمعالجين
في كتاب "مغامرو الروحانيات الجُدد: استطلاع حول تعطّش جديد" (Les nouveaux aventuriers de la spiritualité, enquête sur une soif d’aujourd’hui Broché)، ندرك أن 36% من الباحثين عن المعنى يلجؤون إلى "العيادات" التي تتّبع التحليل والعلاج النفسي. ولأن عَلْمَنة المجتمعات التي نعيش فيها اليوم تسبّبت في "ترحيل الوجود" الكبير على حد تعبير دوركايم ، فليس غريباً أبداً أن تصير عيادات العلاج النفسي الملاذ الذي تلجأ إليه تلك الأرواح الهائمة؛ تلك التي تلبّي نداء حقيقتها العميقة وتتطلع إلى تنمية كل إمكاناتها الداخلية.
وأنا هنا أتوجه بالحديث إلى زملائي؛ كل معالجي النفوس من أطباء نفسيين وعلماء نفس ومعالجين نفسيين في كافة التخصصات، لنتحد معاً ونعيد النظر في مناهجنا بما يلائم هذا الجمهور الجديد.
كما أتوجه إلى كل أولئك الذين يجدون في أنفسهم "متعطّشين"، وأدعوهم ليثقوا في شعورهم وما يمرّون به، وليكُن عطشاً وجودياً، أو تعطّشاً للروح الأصلية، أو رغبة في التحقق. لِكلٍّ حرية اختيار الكلمات التي تبدو له الأدق لوصف حالته. فليطمئنوا إلى أنهم ليسوا وحدهم من يمرونّ بهذه المعاناة؛ ثمة أمثالهم في هذا العالم يواجهون الشيء نفسه، وهم معاً يسهمون في تطّور العالم على كلّ الأصعدة، أو ما يُطلق عليه اليوم بالحدث الأبرز في القرن الواحد والعشرين: رفع وعي العالم.