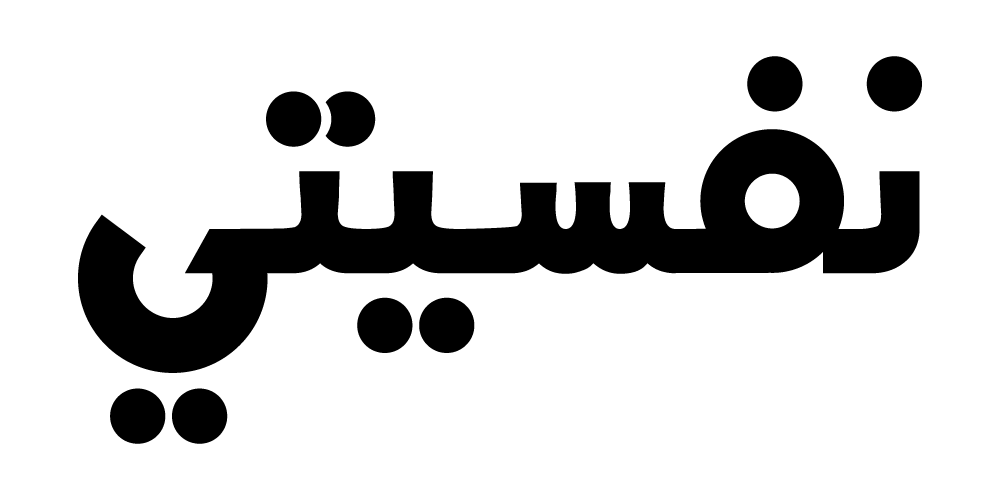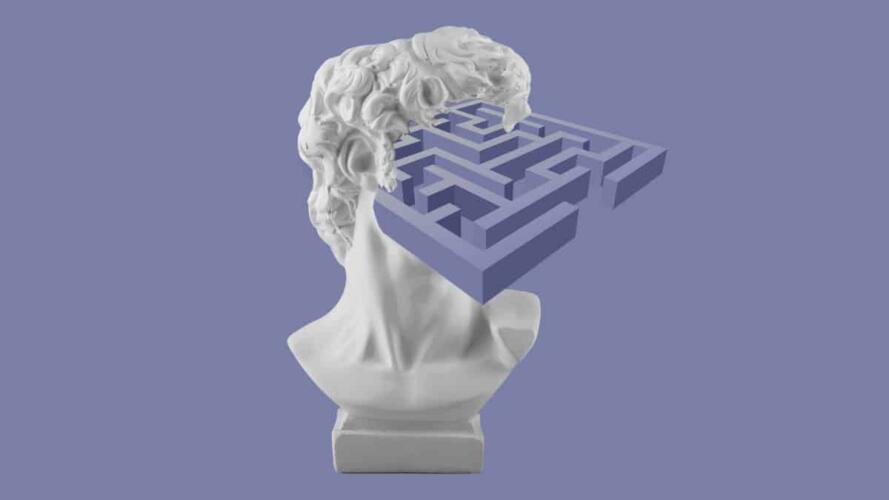ألم يعد الاعتماد على اللاوعي لمعالجة الأعراض النفسية التي تظهر علينا والحيلولة دون انتكاساتنا مجدياً؟ هذا هو موضوع الجدل المحتدم بين المحللين النفسيين والسلوكيين اليوم، وفي هذا المقال يقدم لنا الخبير كريستوف أندريه التفسير.
حين يتعلق الأمر باللاوعي، فالسؤال الذي ينبغي أن يُطرح ليس حول تبنّيه أو رفضه بل حول تطوره. كان اللاوعي في البداية فكرة مغرقة في الرومانسية وَسَمت القرن التاسع عشر.
وقد توقف أغلب علماء النفس المعاصرين بعد فرويد، عن مساءلة الإيمان بفكرة وجود قوى غامضة وطبيعية داخل الإنسان تدفعه إلى تقديم الأفضل عن طريق تحفيز حدسه وإبداعه كما تؤثر فيه سلباً من خلال تغذية حالاته العُصابية وهفواته. لكن، في الوقت الذي لا يزال اللاوعي الفرويدي يحوز شعبية قصوى عند جمهور كبير، يوجد منظور مختلف في طريقه إلى التبلور داخل مختبرات البحث وعيادات العلاج النفسي.
تجارب مخبرية
صار بالوسع اليوم إثبات أن جزءاً مهماً من أنشطتنا الدماغية يحصل بمعزلٍ عن وعينا؛ حيث انصبت مجموعة من الأشغال حول طريقة عمل الذاكرة وكيفية استيقاظ ذكرى غابرة بطريقة فجائية. كما تطرقت هذه الأشغال لعملية التفكير المنطقي أيضاً، وبالتحديد اللغز الكامن خلف تمكنّنا أحياناً من حل مشكلة لا تشغل تفكيرنا في الأساس.
تناولت مجموعة من الأبحاث في طب النفس التصورات اللاواعية التي يحملها مرضى القلق أو الاكتئاب، وقد أظهرت الأبحاث أن المرضى الذين يعانون من رهاب المجتمع تشوشهم الوجوه العدائية التي تظهر على شاشة الكمبيوتر بطريقة لا شعورية ولا واعية، أما بالنسبة إلى مرضى الاكتئاب فقد أبانوا عن قدرة فائقة على التقاط الوجوه والمشاعر الحزينة داخل هذه الصور.
أخذ علم النفس العصبي يقف شيئاً فشيئاً على واقع أن العديد من زلات اللسان والهفوات والأحلام لا يعكس رغبات لا واعية بالضرورة؛ بل قد ينجم ببساطة عن خلل في معالجة القدر الهائل من المعلومات التي نستقبل يومياً من محيطنا وتخزينه. وهذا منظور أقل شاعرية غير أنه مدعوم بالحقائق؛ إذ أفضت هذه الأشغال كلها إلى تأكيد وجود عملية غير واعية فعلاً لكن يكمن الاختلاف في أن الأمر يتعلق باللاوعي المعرفي، لا اللاوعي الفرويدي.
يسعى علماء النفس التقدميون إلى سبر أغوار اللاوعي الجمعي واكتشاف سُبل لفهمه؛ إذ لاحظوا وجود الخوف من الثعابين عند سكان المدن أكثر من خوفهم من الأسلحة النارية أو السيارات، رغم أن هذه الأخيرة موجودة داخل بيئتهم كما أنها لا تقل خطراً عن سابقتها. ومرد الأمر أن الجنس البشري احتفظ في لا وعيه بآثار خوف الأسلاف، والذي كان السبب في بقائه على قيد الحياة.
وعلى هذه الفرضية أن تُخضَع للاختبار؛ وهو ما حصل بعرض صورٍ لقردة كبيرة في السن خائفة من ثعبان أو وردة على قردة صغيرة في السن إذ ثَبُت أن من الصعب بمكانٍ جعل هذه القردة تتبنّى الخوف من الورود، غير أنها تعلّمت في المقابل الخوف من الأفاعي بسرعة كبيرة.
علاجات نفسية حديثة
هذه الرؤية الجديدة للاوعي وجدت صداها كذلك في عيادات العلاج النفسي؛ إذ جزمَ المحللون النفسيون ولمدة الطويلة أنه لا حديث عن الشفاء النفسي الحقيقي دون المرور أولاً باللاوعي، في حين يعرف هذا المجال اليوم عدداً من تيارات العلاج النفسي الحديثة التي لا تتكئ على اللاوعي كأساس العلاج الوحيد أو ذي الأفضلية؛ كالعلاج السلوكي والنظامي،
مع أن التحفظات حول هذا النمط من العلاجات كانت كثيرة في بداية الأمر والجدل حولها كان محتدماً؛ إذ كان البعض مدفوعاً بتعصّبه للتيار الكلاسيكي، فيما بدت أسباب البعض أكثر منطقيةً حيث كانوا يجدونها علاجات غير ناجعةٍ على المدى البعيد وتمحورت توقعاتهم بأن الاكتفاء بمعالجة الاضطرابات دون إحداث تغيير جذري في البنيات اللاواعية الأساسية، من شأنه التسبب للمريض بانتكاساتٍ في المستقبل أو جَعل الأعراض تعاود الظهور على شكل آخر؛ كأن يتحول القلق الذي عولِج سطحياً إلى إكزيما أو اكتئاب.
وقد تم ضحد هذا الاعتراض المقبول على المستوى النظري بالحقائق؛ إذ أكدت متابعة المرضى المتعافين الذين تابعوا علاجهم السلوكي على المدى البعيد، عدم مجابهتهم لأي انتكاسات أو مشكلات فيما بعد؛ بل إن حالتهم على العكس من ذلك قد ازدهرت.
هل يتعلق الأمر بلاوعي واحد أم متعدد؟
خُلاصة الأمر أن كل الأطراف أجمَعت على وجود اللاوعي؛ يبقى محلّ الاختلاف والجدل فقط الأجوبة المتباينة عن تساؤلات من قبيل: عن أي لا وعي نتحدث؟ وكيف نوظّف هذه المعارف الحديثة في علم النفس والممارسات العلاجية؟ هل هذه المعارف في طريقها إلى أن تهيل التراب على اللاوعي الفرويدي وتجعله طي الماضي؟ وهل يقف المنظوران على طرفيّ النقيض؟ أم أن هذه القراءات المختلفة للاوعي ستعمل بالتوازي مع المقاربة الفرويدية كما فعلت العلاجات السلوكية حين وجدت لها مكاناً جنباً إلى جنب مع علاجات التحليل النفسي؟ أما الكلمة الفيصل في كل هذا فتبقى في جُعبة المستقبل.