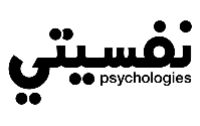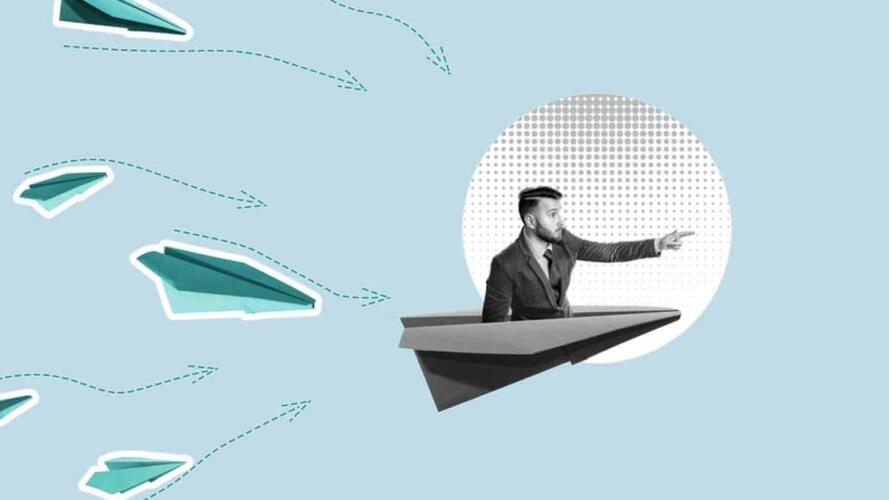
غالباً ما يفيد انتقاد الآخرين في أن ننسب إليهم أخطاء نرتكبها أو صفات نمتلكها ولا نجرؤ في ذات الوقت على الاعتراف بها، وفق ما أوضحه المحلل النفسي “نوربرت شاتيلون”. من أين يأتي الهوس بالحكم الممنهج على الآخرين؟
نوربرت شاتيلون: هذا النوع من إصدار الأحكام على الآخرين قائم أساساً على التمييز بين من أنا ومن هو الآخر وأين يكمن وجه التشابه بيننا وكيف نختلف عن بعضنا البعض. وفي واقع الأمر، فإن إصدار الأحكام أمر ضروري وطبيعي مثل عملية التنفس. وعندما نقوم بالحكم على الآخر تصبح للحكم وظيفة نفسية حيوية تتغير بالمقارنة مع أنفسنا.
لماذا نحكم على الآخر بطريقة سيئة؟
بمجرد أن يزعجني اختلافي مع الآخر أو لا يروق لي تشابه صفاته معي وباختصار يقوض هويتي، فأنا سأدافع عن نفسي. وأفضل طريقة للدفاع بالنسبة للبعض هي الهجوم!
لماذا يزعجنا الاختلاف عن الآخر كثيراً؟
نحن جميعاً بطبيعة الحال نواجه ما يسميه عالم النفس السويسري كارل غوستاف يونغ “جانب الظل”. إنه جانب يتعلق بكل شيء نجد صعوبة في التعرف عليه على الرغم من أنه يشكل شخصيتنا؛ خوفنا وعنفنا وجراحنا ونقاط ضعفنا وألمنا.
ولكننا أيضاً نرفض اعتبار كل تلك العوامل الإيجابية -لأسباب يتعين تحليلها- جزءاً من شخصيتا. هذا هو الجانب المظلم الذي يجعلنا ننسب الصفات السيئة الأخرى للآخرين ونتجنب الاعتراف بها من خلال استخدام آلية إسقاط دقيقة.
الافتراض بأن المرء لا يتمتع بنفس الحالة الاجتماعية أو صفات اللطف التي نمتلكها أمر غير منطقي نوعاً ما. كما أنه من الصعب أن نتخيل أننا أيضاً يمكن أن نتصرف مثل هذا الرجل غريب الأطوار الذي قابلناه ذات مرة. وفي خضمّ كل هذا من الأسهل الحكم على الآخر حتى عندما يُمنح المرء السلطة لإدانة شخص ما
لكن على من أحكم عندما ينبغي أن أحكم؟
الحكم على الآخر هو الحكم على نفسك بالضرورة، لأنك تتحدث عن نفسك أكثر مما تتحدث عن الآخر. في هذا السياق يقول القديس لوقا: “لماذا ترى القذى الذي في عين أخيك ولا ترى الخشبة التي في عينك؟ وبالفعل لهذا المثل وظيفة نفسية. تسمح لنا رؤية القذى في عين الجار بتجنب التفكير في الأمور الخاصة بنا وإنكار الجانب المظلم لدينا وتأجيل عملية استجواب محتملة.
بقوله: “ذلك الشخص يشرب كثيراً” يتجنب المرء النظر في إدمانه على النيكوتين أو الشوكولاتة على سبيل المثال. وبتعليقه “إنها لا تقوم بواجبها الوظيفي بشكل كافٍ” يبرر أن العمل ليس أكثر من مجرد وسيلة. إنها آلية شخصية بسيطة للغاية فالآخر يفعل أو يفكر “بشكل سيئ” وهو مختلف عني، لذلك أفعل ما أعتقد أنه “جيد”. ويقول نظيره: الآخر يفعل ما يعتقد أنه “جيد” وأنا أيضاً، لذلك أفعل ما أعتقد أنه “جيد”. إنه أمر مفيد للغاية! لكن على المدى القصير بالطبع.
لماذا يلجأ المرء إلى اعتماد هذه الحسابات البسيطة مع نفسه؟
لأنه من المؤلم أن تسأل نفسك! لنأخذ مثال صديقتك التي حكمت -على ما يبدو بعبارات سيئة- على الطريقة التي ربت بها أختها أطفالها. لا شك أنها خائفة جداً من ارتكاب الخطأ ذاته إلى درجة أنها تحتاج إلى طمأنة نفسها من خلال إصدار حكم على كل من يفعل الأشياء بشكل مختلف عنها؛ أي الحكم على أختها أولاً وقبل كل شيء.
لسبب وجيه وبسيط: بالحكم على الأم (الأخت) فإنها تتجنب هذا السؤال المحزن للغاية: “هل أنا أم جيدة؟” الاعتراف بأن الآخر يمكن أن يظهر بشكل مختلف وجيد هو أمر مزعزع للاستقرار. على العكس من ذلك فإن الحكم على الآخر وهو يقوم بالعمل بشكل جيد -لأنك أساساً تقوم بذات الشيء بصفة جيدة أيضاً- هو أمر مطمئن بالنسبة لك. هنا مرة أخرى نجد فكرة التمييز الأساسي بين الذات والآخر؛ لكنها طريقة غير صادقة تجعلك تعتبر نفسك أنك عادل وجميل ورائع.
هل هناك من يحتاج إلى الشعور بالطمأنينة أكثر من الآخرين؟
نحن جميعاً بحاجة إلى إثبات أننا موجودون. لكن البعض، بسبب الافتقار إلى الثقة بالنفس والاستقلالية والوعي الذاتي، يدفعهم إلى استخدام هذه الطريقة كوسيلة ليدخلوا في صراع ضد الآخر. إنها معركة شاقة لإثبات الهوية التي يكافح الجميع للعثور عليها في أعماقهم.
هل أولئك الذين لا يحكمون على الآخرين سيكونون أكثر ثقة منهم؟
في الواقع كل منا يحكم ويقضي وقته في الحكم على الآخرين. في رأيي لا يوجد أناس لا يحكمون. من ناحية أخرى هناك البعض ممن يتجنبون إصدار الأحكام خوفاً من ارتكاب خطأ ما أو الحكم عليهم أو درءاً للكراهية أو ببساطة بسبب الإخلاص للأوامر الأخلاقية والتعليمية “لا تقم بذلك أو بهذا” أو حتى لتجنب صراع محتمل بين الأشخاص دون سبب “ماذا يحدث إذا كان الآخر لا يحكم مثلي؟”.
هذا ومن يدعي عدم إصدار الحكم هو في الواقع مشابه لمن يحكم كثيراً: كلاهما يواجه نفس الصعوبة في إعطاء الحكم قيمته الحقيقية، وهي مجرد حقيقة وليست شيئاً آخر. يبدؤون في “التفكير” في الحكم لإعطائه قيمة اجتماعية؛ وبالتالي يقعون في فخ حكم المجتمع عليهم.
ما الذي يجعلنا نفرط في الحكم؟
اختلاف الظروف الشخصية للجميع. لا شك أن تعطشاً مختلفاً للعدالة عبارة عن طريقة لترميم جراح الطفولة لسد الثغرات. الخيارات التي نتخذها طوال الحياة لا ترتبط بالضرورة بأحداث الماضي ولكن بكيفية تأثيره علينا في الحاضر؛ مثلاً اختيار مهنة ما. علاوة على ذلك هناك أشخاص في كل عمل تجاري وظيفتهم هي الحكم.
يبدو لي أن جاذبية هذا النوع من المهنة -السيطرة والخبرة والشهادة- متجذرة في الشعور بالظلم الشخصي أو الاجتماعي، وتهدف بالطبع إلى إجراءات تصحيحية. في المقابل، أعرف طلاباً مختصين في القانون فضلوا المحاماة على القضاء للدفاع وليس لإطلاق حكم حتى ولو كان حكم براءة، حتى لا يقعوا تحت حكم الآخرين عليهم أيضاً. في كلتا الحالتين يتم استخدام الحكم لتصفية الحسابات، وهكذا نسمح لأنفسنا بالتماهي مع وهم إيجاد شرعية الوجود.
كيف لا يمكننا بعد الآن أن ننخدع بأحكامنا الخاصة؟
من الواضح أن العمل على الذات يسمح لنا برؤية التعقيد التنظيمي لأحكامنا بوضوح وفهم الآليات وتحمل نصيبنا من جانبنا المظلم. ما يمكننا جميعاً فعله الآن هو البقاء في حالة تأهب. عندما يتوقف الحكم على الآخر عن كونه تمايزاً بسيطاً وعندما يندمج مع ما هو اعتباطي، يمكننا أن نقول لأنفسنا أننا ضللنا الطريق. وبعد ذلك فإن السخرية من النفس في بعض الأوقات أمر مرحب به دائماً. أهم شيء هو ألا تنخدع، فطالما هناك حياة هناك حكم.
التفاهم يفيد التسامح
وفقاً للتحليل النفسي الكلاسيكي نحكم على مرتكبي الأفعال غير الأخلاقية بقسوة أكبر إذا ما رغبنا في ارتكابها. إنها طريقة لمُعاقبتنا بالوكالة على رغباتنا المحرّمة. يبدو أن التجربة التي أجراها عالم النفس بجامعة كوبلنز-لانداو في ألمانيا ماريو جولويتسر تشير إلى عكس ذلك. لقد عُرضت على ما يقرب من ثلاثمائة شخص سيناريوهات لأفعال تجاوزت سرقة قطعة من الملابس من متجر وركوب مجاني في مترو الأنفاق والعمل كسمكري في السوق السوداء، ثم طُلب منهم وصف مشاعرهم حول إمكانية الانخراط في مثل هذا السلوك السيئ.
بعد ذلك كان عليهم الحكم على الأفراد الذين تجرؤوا على القيام بهذا السلوك. وهنا كانت المفاجأة! بعيداً عن أن تكون أكثر شدة مع أولئك الذين أدركوا رغباتهم المحرمة، فإن هذه السلوكيات -بما في ذلك الأكثر سلطوية أو التي تميل إلى الحكم الذاتي السلبي- كانت على العكس من ذلك أكثر تماشياً معهم، وهكذا تعرفوا على أنفسهم وشعروا بالتعاطف مع أولئك”المذنبين” كما فهموا دوافعهم.
وبالتالي فإن إمكانية التفهم ستساعدنا على أن نكون أقل تعنتاً؛ لكن لا يزال من الضروري الموافقة على مسألة التفهم. وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين كانوا مستعدين نفسياً ليكونوا متساهلين في أحكامهم.
إلقاء اللوم على الأنا العليا
إنها الأنا العليا؛ وهي جزء من الشخصية التي جعلها فرويد مقراً لضميرنا الأخلاقي والتي تشجعنا على الحكم على الأشخاص والأفعال. مثال ذلك في نهاية فترة أوديب -بين حوالي 6 و7 سنوات (عمر النضج)- وهو وريث المحرمات الأبوية والاجتماعية. ومن المفارقات أنه كلما زاد تراخي الوالدين زادت حدة الأنا العليا للطفل، فنتعلم من المحللين النفسيين المختصين في عالم الأطفال إنها استراتيجية نفسية للتعويض عن عدم وجود معايير موثوقة.
الأفراد الأكثر عناداً شديدو الحساسية عند الشعور بالذنب كما أنهم يكونون عرضة للحكم الذاتي السلبي، فضلاً عن أنهم نشؤوا عموماً في بيئة “معتدلة” للغاية. إنهم صارمون مع أنفسهم ويطالبون الآخرين بذات المستوى من الأخلاق ويَهدفون إلى الارتقاء إلى مستوى أخلاقي لا يمكن بلوغه. إن الجانب الغريزي من الأنا العليا يجعلها متطلبة؛ أي إنها تتطلّب مزيداً من الكمال والتضحية. في الحقيقة “يجب أن تكون شخصاً جيداً”. ولكن كلما استسلمنا للأنا العليا وحاولنا أن نكون مثاليين قلّ شعورنا بالرغبة في ذلك.