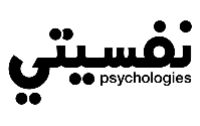كان الصمت سابقاً من آداب المائدة واليوم صار موعد العشاء مع العائلة فرصةً لهم من أجل التواصل الأسري والتعبير عن أنفسهم. لكن ألا ينبغي لأفراد العائلة أن ينتقوا كلماتهم بحكمة؟ فماذا لو أنهم تحدثوا عن أمور ينبغي أن تبقى طي الكتمان؟ سنناقش هذه الفكرة مع الطبيب النفسي “بيير أونجول”.
مجلّة بسيكولولجي: تطورت أساليب التواصل الأسري تطوراً ملحوظاً، فمنذ فترة ليست ببعيدة كنا نسير على نهج “لا كلام على الطعام”.
“بيير أونجول”: ذكرني حديثك بمريضة أخبرتني في إحدى الجلسات أنها تستصعب التعبير عن نفسها، فسألتها عن أسلوب التواصل المتَّبع في عائلتها في طفولتها فأجابتني أن التزام الصمت كان أبرز حقوقها. كان والدها عاملاً يقرع أصابعه عندما يريد أن نناوله الملح ويطرق على طبقه إذا شعر بالاستياء.
عانى الكثيرون من العيش في بيئة كهذه وحتى أنها كانت العرف السائد في المناطق المحرومة، وأما من ولد في عائلة ثرية تُوكَل مهمة تربيته غالباً لطاقم الخدم. وإن الاهتمام بتعلم التواصل بانسجام ظهر في الآونة الأخيرة بالتوازي مع ظهور ثورة ثقافية تمثلت بتقدير الرابطة العاطفية بين الزوجين وتغيير نظرتنا لها التي نورثها للطفل وغيرها من الأمور، ومنذ زمن بعيد لم تعد الغاية من تربية الأطفال تأديبهم وإنما أصبحنا نربيهم ليعبروا عن شخصياتهم، وبدأنا لأول مرة نناقش عواطف الطفل وشكوكه وخصوصيته.
هل يحتمَل أن نشارك مع طفلنا معلومات أكثر مما ينبغي؟
نعم أحياناً. تعرضت “فرونسوا دولتو” لانتقادات واسعة لأنها شجعت الآباء على قول كل ما يخطر في بالهم لأطفالهم دون قيود بيد أنهم أساؤوا فهم رسالتها، فهي شددت على قيمة التحدث مع الطفل وأهمية الإصغاء إليه وإخباره حقيقة القصص التي يرويها ومساعدته في التعبير عن مشاعره، وإن رسالتها تلك رسالة قيّمة لأن الطريقة التي يعلمنا بها آباؤنا التحدث تؤسسنا طول حياتنا. إن أساس المسألة تعزيز ثقة الطفل بنفسه وقدرته على التفكير وبدء أحاديث قيّمة
لكننا شهدنا مبالغةً كبيرةً في هذا الأمر. علّمنا العلاج الأسري الكثير عن الأضرار الناجمة عن اتباع بعض أساليب التواصل الخاطئة؛ لا نعرف فعلاً كيف تُرتكب هذه الأخطاء [يضحك] لكن على أي حال تعلمنا ما الأخطاء التي ينبغي لنا تجنبها، وأبرزها عدم مراعاة الفجوة بين الأجيال الذي يعد كارثةً بحد ذاته. وإقصاء أحد الوالدين للآخر لا يقل فظاعةً، فأنت تزرع في الطفل بفعلك هذا ميلاً لتجاوز الآخرين والتعدي عليهم، فكيف سيحترم معلمه والقانون وزوجته المستقبلية مثلاً؟
هل يختلف نمط التواصل بين عائلة وأخرى؟
هذا بديهي؛ بعض العائلات مكتفية ذاتياً بشكل مبالغ به ومنطوية وترى العالم الخارجي خطيراً، فتجد أن قدرتهم على التواصل مع بعضهم كبيرة وقدرتهم على التواصل مع العالم الخارجي تتضاءل لأنهم يحذرون أطفالهم من ألا يحدّثوا الآخرين عن أنفسهم أو طريقة تفكيرهم. والعكس صحيح أيضاً، فبعض العائلات مفككة ويجعل كل فرد من أفرادها مصلحته أولوليةً على التماسك الأسري ويتحدثون مع أي شخص كان على ألا يكون من أفراد عائلتهم. وعلاقات بعض العائلات غير متوازنة فتجد كل مجموعة من أفرادها تتحالف ضد البقية؛ هذا ما يدعوه التحليل المنهجي “بالمريض المقصود” وهو الشخص الذي نتحدث عنه لنخفي مشاكل أخرى. والقائمة تطول كالعائلات التي لا تتفوه إلا بكلام بذيء.
لهذا يفيد أن تُجرى مكالمات العلاج الأسري بالصوت والصورة وأن تسجَّل لأن أفراد العائلة نادراً ما يدركون حقيقة أسلوب التواصل فيما بينهم فيكتشفون من خلال مشاهدة مقاطع من الجلسة أنهم لا يستمعون لبعضهم. مثلاً التقيت بأم واجهت صعوبةً في منح ابنتها المراهقة فرصةً لتنضج، قالت لي بعد عدة أسابيع: “وأخيراً فهمت المشكلة، سأتراجع وأدعها تتدبر أمورها بنفسها قليلاً” ثم رأيناها في مقطع الفيديو تحمل حقيبة ابنتها المدرسية عنها وهي تغادر الجلسة.
هل تنجم عن التحولات الأسرية صعوبات جديدة في التواصل؟
أجل. نجد في العائلات التي يعيلها أحد الوالدين غالباً التباساً في الأدوار؛ إذ يجب أن يتولى الشخص ذاته دور القيادة والمواساة ويقدم للطفل العلامات الفارقة التي تميز كل والد، وهذا سلاح ذو حدّين لكنه أمر جديد في الحالتين. وأما العائلات التي تعاد هيكلتها يتداخل محيط التواصل فيها: بين الأب وزوجته السابقة من جهة، وزوجته الجديدة، ووالد أبنائها، والجدَّين من كل طرف من جهة أخرى. من يحق له الكلام؟ ما هي خواطرنا وماذا نخفي؟
تؤلم كل هذه الأفكار أحياناً المرء وتزعزع استقراره. أعتقد أنه علينا أيضاً ألا نغفل المنافع التي يمكننا استخلاصها من تعدد أهل الرأي في العائلة فهي تثري وجهات النظر وأنماط التواصل وقد تكون أمراً محفزاً جداً. في الحالتين تعد هذه العائلات مختبراً حقيقياً نكتشف منافعه ومضاره وندرسها.
هل لا يزال أفراد الأسرة يخفون أسرارهم عن بعضهم حتى الآن؟
لم يعد هذا شائعاً كالسابق لأن حرية الحديث زادت عند سقوط المحظورات. لكن على حسب قول بعض الأهالي لم تتغير قدرتنا على كتم بعض الأسرار مثل انتحار الخالة أو الابن غير الشرعي للأب أو إجهاض البنت. رغم التسامح الاجتماعي نجد أموراً لا تُذكر لأنها تمس بنرجسية من يكتمها أو من لا يجب أن يعرفها.
ومن أسباب كتم الأسرار أن من يخفيها لا يظن أنها مهمة ليبوح بها، وقد يكون مصيباً في ذلك. شاع كثيراً في السنوات الأخيرة أقوال عن ضرورة كشف الأسرار وأن كتمانها حتماً مصدر معاناة وذاعت بين الناس بالذات عند ذكر قضية حالة الأطفال الذين ولدوا ولادةً مجهولة؛ لكنني أتساءل ماذا سيستفيد الطفل – حتى عندما يكون بالغاً – عندما يعرف أن والدته كانت غير سوية أو أن والده مجرماً.
هل حثثت أحدهم يوماً ألا يبوح بسره؟
بالتأكيد. فما كان محل التساؤل آنذاك ليس حساسية السر بل قدرة المعنيين على تلقيه؛ إذ من الضروري أن تقيّم كل حالة على حدة: هل تكمن مصلحة الآخر ببوحك للسر أم بكتمانه؟ أعتقد أننا ربما سنعيش بسعادة دون معرفة حقيقة تعنينا وأن السر المكشوف قد يخل بتوازن حياتنا الحالي.
هل ينبغي أن نستشيرك حتى نتعلم كيف نفصح عن سر نعرفه؟
نعم في معظم الحالات، رغم أن الطلب لا يكون واضحاً دائماً. نتدخل عندما تكون حالة الزوجين أو الأسرة سيئة ونشعر أن حالها سيكون أفضل إذا أفصحوا عن أسرارهم. ولأزيدك من الشعر بيتاً؛ يستشيرني البعض لإرشادهم إلى طريقة يعلِمون فيها الطرف الآخر بحدث ما مثل انفصال الوالدين أو ولادة طفل أو مرض أحد الأحباء أو وفاته، فيسألونني: كيف أخبره/ا؟ من يخبره/ا؟ متى نخبره/ا؟ ونجد هنا أيضاً أن المسألة ليست إصدار دليل تواصل وإنما فهم سبب استصعاب فرد من تلك العائلة بالذات وفي تلك الفترة بالذات إعلام البقية بذاك الخبر، وما الذي يمكننا تغييره حتى نسهّل عليهم التواصل فيما بينهم.
وما مشكلة التواصل إلا غيض من فيض، وعَرَض من أعراض المشكلة. في بعض الأحيان لا يكمن حل المشكلات بالكلمات لكن ذلك فقط لأننا نمتنع عن الكلام ولا نتفوه إلا بالأسئلة المتطفلة والتذمر والهواجس. لا يهدف التدخل العلاجي دوماً إلى حثّ الجميع على التحدث وإنما إلى مساعدتهم على التمييز بين ما يجب أن يُقال وما يجب أن يُكتم، وبين ما يفضّل قوله في مكان آخر أو السكوت عنه؛ ما علينا إلا أن نتعلم الصمت.